نتعرف اولا على منهج الألغاز
وأثره في الفقه الإسلامي
لقد تنوعت أساليب العلماء في عرض مسائل الفقه الإسلامي، وابتكروا طرقا متنوعة في بحثه وعرضه، ومن تلك الطرق:
"أسلوب الألغاز الفقهية"
واللغز في اللغة: هو الكلام الملبس،
أما الألغاز الفقهية فهي: تلك المسائل التي يقصد إخفاء وجه الحكم فيها؛ لأجل الامتحان.
وللألغاز أسماء أخرى، فيسمى المعاياة،
والعويص، والمعمى، والرمز، والمحاجاة، وأبيات المعاني، والمرموس، والتأويل، والتعريض. وتختلف هذه الأسماء
بحسب اختلاف وجوه اعتباراته وبحسب الفن الذي تناوله.
نشأ هذا العلم في ظلال السنة النبوية، وردود الصحابة الكرام على الأسئلة والألغاز التي كانت ترد إليهم:
فقد سلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى مع أصحابه، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم
والعلماء الأعلام رحمهم الله تعالى،
إلا أن هناك نوعا من الألغاز يحرم التعامل به لما فيه من صعوبة وغموض وتعمية.
واللغز لا يأتي بشيء جديد في الأحكام الشرعية،
وإنما هو عبارة عن تحوير للحكم الشرعي وإخفائه، كنوع من السؤال والاختبار ووسيلة من وسائل الإثارة
والتعليم، ويجوز استخدام هذه الطريقة في التعليم، لكن بشرط أن تكون الألغاز الفقهية صادرة من عالم،
وأن تكون في المسائل الفقهية الواقعية، وأن لا يعمل بها أمام العامة، كما لا يجوز المبالغة في التعمية والإلغاز،
ويجب بيان اللغز، وأن يكون الهدف من وراء ذلك طلب العلم، وليس من أجل التعجيز أو التفاخر.
والألغاز الفقهية وسيلة لشحذ الأذهان،
وطريقة تعليمية وترفيهية مفيدة، وهذا الفن من فنون القفه مما يقوي العقل، ويزيده دربة، ويكسب صاحبه
خبرة عند التمرن بها.
ولقد رتب الفقهاء ألغازهم على أبواب الفقه،
ومسائلها تدور على مذهب واحد من المذاهب الفقهية الأربعة،
كما تتميز بالإيجاز والاختصار، وأحيانا كثيرة تصاغ في شكل أبيات منظومة.
وبالإضافة إلى علم الفقه لقد دخلت الألغاز فنونا متفرقة من العلوم:
كفن القراءات، والنحو، والحساب، والفرائض، ومصطلح الحديث.
----
المألفـــات في الالغـــاز
ألفت في الألغاز الفقهية العديد من الكتب أشهرها:
1 -درة الغواص في محاضرة الخواص لابن فرحرن المالكي (799هـ)،
2 -حلية الطراز في حل مسائل الألغاز لأبي بكر الجراعي الحنبلي (883هـ)،
3 -الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية لابن الشحنة (921هـ)،
كما أن كتب الأشباه والنظائر احتوت أبوابا خاصة في الألغاز الفقهية،
كالأشباه والنظائر للسبكي (771هـ)
ولابن نجيم (970هـ)
إضافة إلى أن معظم كتب الفروع الفقهية تورد بعض
المسائل الفقهية على شكل الألغاز.
ويستحق الاهتمام بهذا الفن
- الذي اعتنى به السابقون، وأهمله اللاحقون -
ومدارسته، وجمع وتتبع مخطوطاته، لتحقيقها ونشرها،
والاستفادة منها.
نشأة الألغاز الفقهية
الأصل عند من اشتغل في الألغاز والأحاجي:
هو
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فلقد سلك المصطفى-صلى الله عليه وسلم-
هذا المعنى مع أصحابه وتعاطاه، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي؟"
قال: فوقع الناس في شجر البوادي !
ثم قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت، (وفي رواية: فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر)
ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟
قال: "هي النخلة ".
قال: فذكرت ذلك لعمر..
قال: لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا!
قال: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت.
وفي هذا الحديث فوائد وأحكام عظيمة، بسطها العلماء في شروحهم
ألخصها في النقاط التالية:
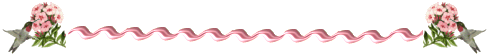 أولا: فيه استحباب إلقاء العالم المسألة على تلامذته ليختبر أفهامهم( )، ويمتحن أذهانهم بما يخفى، مع بيانه لهم إن لم يفهموه، ويرغبهم في الفكر.
أولا: فيه استحباب إلقاء العالم المسألة على تلامذته ليختبر أفهامهم( )، ويمتحن أذهانهم بما يخفى، مع بيانه لهم إن لم يفهموه، ويرغبهم في الفكر.
ثانيا: فيه: التحريض على الفهم في العلم، ولهذا بوب عليه الإمام البخاري "باب الفهم في العلم".
ثالثا: فيه جواز اللغز مع بيانه، ففيه دليل على أنه-صلى الله عليه وسلم-كان يقصد الألغاز في كلامه في بعض الأحيان،
شحذا لهمم أصحابه وأذهانهم.
رابعا: فيه: جواز ضرب الأمثال والأشباه؛ لزيادة الإفهام،
وتصوير المعاني في الذهن، وتجديد الفكر، والنظر في حكم الحادثة.
خامسا: فيه إشارة إلى أن الملغز له ينبغي أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال، وأن الملغز ينبغي له أن لا يبالغ في التعمية، بحيث لا يجعل للملغز بابا يدخل منه،
بل كلما قربه كان أوقع في نفس سامعه.
سادسا: فيه: توقير للكبار، كما فعل ابن عمر، لكن إذا لم يعرف الكبار المسألة فينبغي للصغير الذي يعرفها أن يقولها.
سابعا: فيه: استحباب الحياء ما لم يؤد إلى تفويت مصلحة،
ولهذا تمنى عمر أن يكون ابنه لم يسكت، وقد بوب عليه المؤلف-يعني الإمام البخاري-في العلم وفي الأدب .
ثامنا: فيه: سرور الإنسان بنجابة ولده، وحسن فهمه،
لقول عمر-رضي الله عنه-: "لأن تكون قلت: هي النخلة أحب إلي.. " أراد بذلك أن النبي-صلى الله عليه وسلم-
كان يدعو لابنه، ويعلم حسن فهمه ونجابته.
تاسعا:فيه: أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه، لأن العلم منح إلهية، ومواهب رحمانية، وأن الفضل بيد الله، يؤتيه من يشاء.
عاشرا: فيه: دلالة على فضيلة النخل، فقد قال المفسرون "ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة،":
هي النخلة أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء.
((تلخيص أختي خديجة 
وقال العلماء:
وشبه النخلة بالمسلم في كثرة خيرها، ودوام ظلها، وطيب ثمرها، ووجوده على الدوام، فإنه من حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى بيبس، وبعد أن ييبس يتخذ منه منافع كثيرة، ومن خشبها وورقها وأغصانها، فيستعمل جذوعا وحطبا وعصيا ومخاصر وحصرا وحبالا وأواني وغير ذلك، ثم آخر شئ منها نواها، وينتفع بها علفا للإبل، ثم جمال نباتها، وحسن هيئة ثمرها، فهي منافع كلها، وخير وجمال، كما أن المؤمن خير كله، ومن كثرة طاعته ومكارم أخلاقه، ويواظب على صلاته وصيامه وقراءته وذكره والصدقة والصلة، وسائر الطاعات، وغير ذلك، فهذا هو الصحيح في وجه التشبيه، وقيل: وجه الشبه أنه إذا قطع رأسها ماتت بخلاف باقي الشجر، وقيل: لأنها لا تحمل حتى تلقح، والله أعلم.
حادي عشر: واستدل به مالك على أن الخواطر التي تقع في القلب من محبة الثناء على أعمال الخير لا يقدح فيها إذا كان أصلها لله، وذلك مستفاد من تمني عمر المذكور، ووجه تمني عمر رضي الله عنه ما طبع الإنسان عليه من محبة الخير لنفسه ولولده، ولتظهر فضيلة الولد في الفهم من صغره، وليزداد من النبي صلى الله عليه وسلم حظوة، ولعله كان يرجو أن يدعو له إذ ذاك بالزيادة في الفهم.
وفيه: الإشارة إلى حقارة الدنيا في عين عمر، لأنه قابل فهم ابنه لمسألة واحدة بحمر النعم، مع عظم مقدارها وغلاء ثمنها.
وقد يستطيع بعض أهل العلم أن يستنبط من هذا الحديث فوائد تربوية واجتماعية واقتصادية كثيرة.