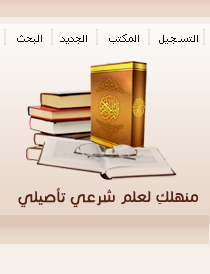

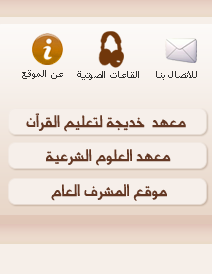
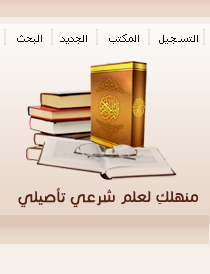 |
 |
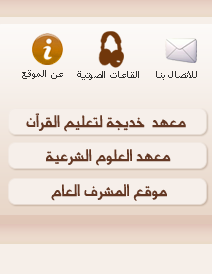 |
|
|
|
|
#1 |
|
نفع الله بك الأمة
|
من آية 240 إلى آية 242 . وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "240. لقد شرع الله لكم فيما شرع من أحكام، أن على المسلّم قبل أن يحضره الموت أن يوصِي لزوجته التي على قيد الحياة بما تنتفع به انتفاعًا مستمرًا لمدة حول من وفاته، ولا يصح أن يخرجها أحد من مسكن الزوجية.المراد بقوله: مَّتَاعًا ما تتمتع به الزوجة من السكن والنفقة بعد وفاة زوجها بوصية منه.إِلَى الْحَوْلِ :للتنصيص على أن هذه المدة تمتد حولًا كاملًا منذ وفاة زوجها، إذ كلمة حول تدل على التحول أي حتى تعود الأيام التي حدثت فيها الوفاة.وقوله " غَيْرَ إِخْرَاجٍ "حال من أزواجهم أي غير مخرجات من مسكن الزوجية، فلا يصح لورثة الميت أن يخرجوهن من مسكن الزوجية بغير رضاهن، لأن بقاءهن في مسكن الزوجية حق شرعه الله لهنَّ، فلا يجوز لأحد أن يسلبه منهن بغير رضاهن. فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ: فَإِنْ خَرَجْنَ من منزل الزوجية برضاهن ورغبتهن فَلا إثم عليكم أيها المسلمون فيما فعلن في أنفسهن من أمور لا ينكرها الشرع كالتزين والتطيب والتزوج بعد انتهاء عدتها وهي أربعة أشهر وعشرة أيام. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ:أي: عزيز في انتقامه ممن تعدى حدوده، إذ هو القاهر فوق عباده، حكيم فيما شرع لهم من آداب وأحكام فينبغي أن يمتثل الناس أوامره ويجتنبوا ما نهاهم عنه. الوسيط. وللعلماء في تفسير هذه الآية اتجاهان مشهوران:أما الاتجاه الأول: فيرى أصحابه أن هذه الآية منسوخة لأنها توجب على الزوج حين مشارفة الموت أنْ يوصِي لزوجته بالنفقة والسكنى حولًا، ويجب عليها الاعتداد حولًا، وهي مُخَيَّرة بين السُّكنى في بيته حولًا ولها النفقة، وبين أن تخرج منه ولا نفقة لها، ولم يكن لها ميراث من زوجها. قالوا: وكان هذا الحكم في ابتداء الإسلام. وقد نُسخ وجوب الوصية بالنفقة والسكنى بآية المواريث وبحديث " لا وصية لوارث" قال أبو أمامة الباهلي :سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يقولُ في خُطبتِهِ عامَ حجَّةِ الوداعِ "إنَّ اللَّهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ، فلا وصيَّةَ لوارثٍ"الراوي : أبو أمامة الباهلي - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح ابن ماجه-الصفحة أو الرقم : 2210 - خلاصة حكم المحدث : صحيح , حيث جعل لها الربع أو الثمن عوضًا عن النفقة والسكنى .لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُمِمَّا تَرَكْتُم ..." النساء:12. ونسخ وجوب العدة حولًا بقوله- تعالى- قبل ذلك وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"البقرة:234. .الآية.قالوا: ومما يشهد لذلك ما أخرجه أبو داود والنسائي: عن ابنِ عبَّاسٍ، في قولِه" وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ "نُسِخَ ذلِكَ بآيةِ الميراثِ مِمَّا فرضَ لَها منَ الرُّبعِ والثُّمن، ونسخَ أجلَ الحولِ، أن جُعِلَ أجلُها أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا"الراوي : عكرمة مولى ابن عباس - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم : 3545 - خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح .الدرر السنية. وجمهور المفسِّرين على أنَّ هذه الآية منسوخةٌ حكمًا بقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وقيل النفقة كذلك منسوخةٌ بآية المواريث.يُنظر: الناسخ والمنسوخ:للنحاس :ص: 239، والناسخ والمنسوخ: لابن حزم (ص: 29)، والوجيز: للواحدي :ص: 176، وتفسير ابن كثير:1/658-659. أما الاتجاه الثاني: فيرى أصحابه أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة وممن ذهب إلى هذا الاتجاه التَّابعيُّ الجليلُ مُجاهدُ بنُ جَبرٍ فقد قال ما ملخصه: دلت الآية الأولى وهي " يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" على أن هذه عدتها المفروضة تعتدها عند أهل زوجها. ودلت هذه الآية بزيادة سبعة أشهر وعشرين ليلة على العدة السابقة تمام الحول، وأن ذلك من باب الوصية للزوجات أن يمكن من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولًا كاملًا ولا يُمْنَعْنَ من ذلك لقوله تعالى " غَيْرَ إِخْراجٍ" فإذا انقضت عدتُهُنَّ بالأربعة أشهر والعشر- أو بوضع الحمل- واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل فإنهن لا يُمْنَعْنَ من ذلك لقوله تعالى " فَإِنْ خَرَجْنَ" .ومن المفسرين الذين أيدوا هذا الاتجاه الإمام ابن كثير ،كما أيده أيضًا الإمام الفخر الرازي في تفسيره.الوسيط. وجُمهورُ أهلِ العِلمِ إلى أنَّه يجِبُ على المرأةِ أن تعتَدَّ في البيتِ الذي كانت تَسكُنُ فيه عند مَوتِ زَوجِها.الدرر السنية. "وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ" 241. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ :وقد اختلف أهل العلم في المعنية بهذه الآية من المطلقات. فقال بعضهم: عني بها الثيِّبات اللواتي قد جومعن. قالوا: وإنما قلنا ذلك، لأن -الحقوق اللازمة للمطلقات غير المدخول بهن في المتعة، قد بينها الله تعالى ذكره في الآيات قبلها, فعلمنا بذلك أن في هذه الآية بيان أمر المدخول بهن في ذلك. وقال آخرون: بل في هذه الآية دلالة على أن لكل مطلقة متعة، وإنما أنزلها الله تعالى ذكره على نبيه صلى الله عليه وسلم، لما فيها من زيادة المعنى الذي فيها على ما سواها من آي المتعة, إذ كان ما سواها من آي المتعة إنما فيه بيان حكم غير الممسوسة إذا طلقت, وفي هذه بيان حكم جميع المطلقات في المتعة. .تفسير الطبري. حكم المتعة: اختلف العلماء هل المتعة في الآية على الوجوب أم على الندب؟ فمنهم من قال:إن كان الطلاق بعد الدخول ، لم تجب المتعة عند جمهور الفقهاء ، بل تستحب . المتعة تجب للمطلقة قبل الدخول، إذا لم يكن لها مهر محدد عند العقد. لقوله تعالى " لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ " البقرة/236 . وذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب المتعة لكل مطلقة، وهو أحد قولي الشافعي، ورواية عن أحمد، ومذهب الظاهرية، وأبي ثور، وقال به من السلف سعيد بن جُبير، والزُّهْرِي وقَتَادة والضَّحَّاك، واختاره ابن جرير الطبري، وابن تيمية، والحافظ ابن حجر.ا.هـ.في موقع الإسلام سؤال وجواب-وينظر: تفسير ابن كثير :1/ 660, الإنصاف :8/ 302، المحلى :10/3 ، تفسير الطبري :4/ 301، مصنف عبد الرزاق 7/70، مجموع الفتاوى :32/ 27. وقيل: إن المتعة مستحبة للجميع وليست واجبة لأحد من النساء وهو مذهب المالكية. كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم. وسبب الخلاف بين الفقهاء في وجوب المتعة أو استحبابها هو أنه قد ورد في القرآن الكريم آيات كريمة ظاهرها التعارض، فمنها ما يوجب المتعة على الإطلاق، ومنها ما يوجب المتعة عند عدم ذكر المهر المفروض لها، ومنها ما لم ينص على المتعة أصلا فلهذا وقع الخلاف بين الفقهاء.كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم. "كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ" 242. ختم- سبحانه - هذه الآيات المتعلقة بأحكام الأسرة بقوله: كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. أي: مثل هذا البيان الحكيم الواضح الذي بيَّنَ الله لكم به الأحكام السابقة، يبين لكم جميع آياته. الآيات أي العلامات الهادية إلى الحق . وأحكامه التي أنتم في حاجة إليها. تعقلون: أي تتدبرون الأشياء وتذعنون لما أودع فيها من الحِكم والمصالح إذعانًا يكون له الأثر في الأعمال. وبعد ذلك ينتقل الحديث إلى علاج قضية إيمانية وهو أن الله حين يقدر قدرًا لا يمكن لمخلوق أن يفلت من هذا القدر كما هو مبين في الآية التالية. |
|
|

|
|
|
#2 |
|
نفع الله بك الأمة
|
من آية 243إلى آية251 . "أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ" 243. والمقصود من هذه الآية الكريمة حض الناس جميعًا على الاعتبار والاتعاظ وزجرهم عن الفرار من الموت هلعًا وجبنًا، فحين يقدر الله قدرًا لا يمكن لمخلوق أن يفر من هذا القدر. أَلَمْ تَرَ : أي ألم تعلم يا محمد أو أيها السامع أو لم ينته علمك إلى خبر هؤلاء.إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ: يُخبر تعالى عن قصَّة الذين فرُّوا مِن دِيارهم وهم جموعٌ مكوَّنةٌ من آلاف الأشخاص، وقد كان فرارُهم خوفًا من نزول الموت بهم، إما لوباءٍ حلَّ في موطنِهم، أو لعدوٍّ هاجَمَهم في أرضهم. فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ: فأَماتَهم الله عزَّ وجلَّ جميعًا؛ معاملةً لهم بنَقيض قصدِهم، ثم أحياهم بعدَ مُدَّة من الزَّمن تفضلًا منه سبحانه وتعالى عليهم و رحمة بهم ولطفًا وحلمًا، وبيانًا لآياته لخلقه بإحياء الموتى ؛ فالله جلَّ جلاله صاحب الإحسان والإنعام على النَّاس كافَّةً، لكنَّ أكثرهم لا يُقابِلون ذلك الفضلَ بما يستحقُّه من شُكرٍ. فلا تزيدهم النعمة شكرا، بل ربما استعانوا بنعم الله على معاصيه، وقليل منهم الشكور الذي يعرف النعمة ويقر بها ويصرفها في طاعة المنعم. وفي قوله: وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ إنصاف للقلة الشاكرة منهم، ومديح لهم على استقامتهم وقوة إيمانهم. "وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" 244. والسبيل: الطريق. وسميت المجاهدة سبيلا إلى الله لأن الإنسان يسلكها فيصل إلى ما يرضي الله، ويعلى والسبيل: الطريق. وسميت المجاهدة سبيلا إلى الله لأن الإنسان يسلكها فيصل إلى ما يرضي الله، ويعلي كلمته.ويعز دينه. أي، قاتلوا أيها المسلمون في سبيل إعلاء كلمة الله، والدفاع عن دينه، واعلموا أنه- سبحانه - عليم بكل أقوالكم صالحها وطالحها، عليم بكل ما يدور في نفوسكم وخواطركم، وسيجازى المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته. فأمر تعالى بالقتال في سبيله، وهو قتال الأعداء الكفار لإعلاء كلمة الله ونصر دينه، فقال: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم - أي: فأحسنوا نياتكم واقصدوا بذلك وجه الله، واعلموا أنه لا يفيدكم القعود عن القتال شيئًا، ولو ظننتم أن في القعود حياتكم وبقاءكم، فليس الأمر كذلك، ولهذا ذكر القصة السابقة توطئة لهذا الأمر، فكما لم ينفع الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت خروجهم، بل أتاهم ما حذروا من غير أن يحتسبوا، فاعلموا أنكم كذلك. كما أن الحذر لا يغني من القدر كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلا ولا يباعده ، بل الأجل المحتوم والرزق المقسوم مقدر مقنن لا يزاد فيه ولا ينقص منه كما قال تعالى "الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ " آل عمران : 168. "مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ " 245. ولما كان القتال فى سبيل الله لا يتم إلا بالنفقة وبذل الأموال في ذلك، أمر تعالى بالإنفاق في سبيله ورغب فيه وسماه قرضا - والاستفهام في قوله:مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ.. للحض على البذل والعطاء- من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فينفق ما تيسر من أمواله في طرق الخيرات، خصوصا في الجهاد، والحسن هو الحلال المقصود به وجه الله تعالى، فيضاعفه له أضعافًا كثيرة الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، بحسب حالة المنفِقِ، ونيته ونفع نفقته والحاجة إليها، ولما كان الإنسان ربما توهم أنه إذا أنفق افتقر دفع تعالى هذا الوهم بقوله: وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ - أي: يوسع الرزق على من يشاء ويقبضه عمن يشاء، فالتصرف كله بيديه ومدار الأمور راجع إليه، فالإمساك لا يبسط الرزق، والإنفاق لا يقبضه، ومع ذلك فالإنفاق غير ضائع على أهله، بل لهم يوم يجدون ما قدموه كاملًا موفرا مضاعفًا، فلهذا قال: وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ: فيجازيكم بأعمالكم. ففي هذه الآيات دليل على أن الأسباب لا تنفع مع القضاء والقدر، وخصوصا الأسباب التي تترك بها أوامر الله. وفيها: الآية العظيمة بإحياء الموتى أعيانا في هذه الدار. وفيها: الأمر بالقتال والنفقة في سبيل الله، وذكر الأسباب الداعية لذلك الحاثة عليه، من تسميته قرضا، ومضاعفته، وأن الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.تفسير السعدي. "أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ" 246. أي ألم ينته إلى علمك قصص هؤلاء الملأ - والملأ : اسم للجمع كالقوم والرهط ، والملأ في هذه الآية القوم ؛ لأن المعنى يقتضيه.-من بني إسرائيل من بعد موسى في عصر داود عليه السلام، وكان بينهما زمان طويل. وهذه الآية هي خبر عن قوم من بني إسرائيل نالتهم ذلة وغلبة عدو لهم وأُخرجوا من ديارهم وأبنائهم بالقهر،لذا احتاج هؤلاء القوم إلى القتال لمدافعة العادين عليهم ، فقالوا لنبي لهم بعد أن ذاقوا مرارة الهزيمة: أبعث لنا ملكًا يقودنا للقتال في سبيل الله، وكانت أنبياء بني إسرائيل تسوسهم، كلما مات نبي خلفه نبي آخر، فلما قالوا لنبيهم تلك المقالة قال لهم نبيهم :قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا : أي: لعلكم تطلبون شيئا وهو إذا كتب عليكم لا تفوا بما تقولون ولا تقومون به، فعرض عليهم العافية فلم يقبلوها، واعتمدوا على عزمهم ونيتهم، فقالوا: قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا- أي: أي شيء يمنعنا من القتال وقد ألجأنا إليه، بأن أُخْرِجنا من أوطاننا وسُبِيَت ذرارينا، فهذا موجب لكوننا نقاتل ولو لم يكتب علينا، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ :لما لم تكن نياتهم حسنة ولم يقوَ توكلهم على ربهم فلما كتب عليهم القتال تولوا فجبنوا عن قتال الأعداء وضعفوا عن المصادمة، وزال ما كانوا عزموا عليه، واستولى على أكثرهم الخور والجبن إلا قليلا منهم فعصمهم الله وثبتهم وقوى قلوبهم فالتزموا أمر الله ووطنوا أنفسهم على مقارعة أعدائه، فحازوا شرف الدنيا والآخرة، وأما أكثرهم فظلموا أنفسهم وتركوا أمر الله، فلهذا قال: والله عليم بالظالمين.أي عليم بالذين يظلمون أنفسهم وأمتهم بترك الجهاد دفاعا عنها، وحفظا لحقوقها، فيصبحون في الدنيا أذلاء مستضعفين، وفي الآخرة أشقياء معذبين، وفي هذا وعيد لأمثالهم لا يخفى. "وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ" 247. ثم بيَّن القرآنُ ما أخبرهم به نبيُّهم ليحملهم على الطاعة والامتثال فقال-تبارك وتعالى:وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا: أي وقال لهم نبيهم بعد أن أوحي إليه بما يوحَى: إن الله-تبارك وتعالى- وهو العليم الخبير بأحوال عبادِه قد بعث لكم ومن أجل مصلحتكم طالوت ليكون ملكًا عليكم، وقائدًا لكم في قتالكم لأعدائكم، فأطيعوه واتبعوا ما يأمركم به. قَالُواأَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ : أَنَّىأداة استفهام بمعنى كيف، والاستفهام هنا للتعجب من جعل طالوت ملكًا عليهم. أي قالوا لنبيهم منكرين ومتعجبين من اختيار طالوت ملكا عليهم: كيف يكون له الملك علينا والحال أننا أحق بالملك منه لأننا أشرف منه نسبًا، إذ منا من هو نسل الملوك أما طالوت فليس من نسلهم، وفضلا عن ذلك فهو لا يملك من المال ما يملكه بعضنا فكيف يكون هذا الشخص مَلِكًا علينا؟فأنت تراهم لانعدام المقاييس الصحيحة عندهم ظنوا أن المؤهلات الحقيقة لاستحقاق الملك والقيادة إنما تكون بالنسب وكثرة المال أما الكفاءة العقلية، والقوة البدنية، والقدرة الشخصية فلا قيمة لها عندهم لانطماس بصيرتهم، وسوء تفكيرهم. قَالَإِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ: أي قال لهم نبيهم مُدللا على أحقية طالوت بالقيادة: إن الله-تبارك وتعالى- اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ:أي اختاره وفضله عليكم واختياره يجب أن يقابل بالإذعان والتسليم. وثانيا: وَزادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ : أي أن الله-تبارك وتعالى- منحه سعة في العلم والمعرفة والعقل والإحكام في التفكير المستقيم لم يمنحها لكم، السعة في العلم الذي يكون به التدبير، ومعرفة مواطن ضعف الأمة وقوتها وجودة الفكر في تدبير شئونها. وثالثا: في الْجِسْمِ بأن أعطاه جسمًا قويًّا ضخمًا مهيبًا – يعين على الشجاعة والقدرة على المدافعة والهيبة والوقار. وهذه الصفات ما وجدت في شخص إلا وكان أهلًا للقيادة والريادة ، وفضلا عن كل ذلك فمَالك المُلْك هو الذي اختاره فكيف تعترضون يا من تدَّعُون أنكم تريدون القتال في سبيل الله؟ لذا نراه- سبحانه - يضيف المُلك الحقيقي إليه فيقول: وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُأي: يعطي ملكه لمن يشاء من عباده لحكمة يعلمها سبحانه. فلا يجوز لأحد أن يعترض على اختياره، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ : والله واسع الفضل والعطاء. عليم ببواطن وعواقب الأمور. "وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ " 248. ثم حكى القرآن أن نبيهم لم يكتف بهذه الدلائل السابقة الدالة على صلاحية طالوت للقيادة، وإنما ساق لهم بعد ذلك من العلامات التي تشهد بحقيقته بهذا المنصب ما يثبت قلوبهم، ويزيل شكهم ويشرح نفوسهم . ذكر لهم نبيهم أيضا آية حسية يشاهدونها وهي إتيان التابوت الذي قد فقدوه زمانًا طويلا .والمراد به صندوق التوراة وكانوا إذا حاربوا حمله جماعة منهم ويتقدمون به أمام الجيش فيكون ذلك سبب نصرهم.والمعنى: وقال لهم نبيهم ليقنعهم بأن طالوت جدير بالملك إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أي علامة مُلكه وأنه من الله-تبارك وتعالى- أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ أي أن يرد عليكم التابوت الذي سُلب منكم فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ: أي في إتيانه سكون لنفوسكم وطمأنينة لها أو مودع فيه ما تسكنون إليه وهو التوراة " وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ " من آثار تعتزون بها، وترون فيها صلة بين ماضيكم وحاضركم . فأتت به الملائكة حاملة له وهم يرونه عيانًا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ : الآية: العلامة. أي: إن في ذلك الذي أتاكم به طالوت لآية عظيمة وعلامة ظاهرة لكم تدل على أحقية طالوت بالمُلك والقيادة إن كنتم مؤمنين بآيات الله وبالحق الذي جاء به أنبياؤه. وبذلك نرى أن القرآن الكريم قد حكى لنا أن هؤلاء القوم من بني إسرائيل قد جاءهم نبيهم بأنصع الحُجج، وأوضح الأدلة، وأثبت البراهين التي تؤيده فيما يدعوهم إليه. "فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ" 249. أي: لما تملَّك طالوت ببني إسرائيل واستقر له الملك تجهزوا لقتال عدوهم، فلما فصل أي خرج طالوت بجنود بني إسرائيل وكانوا عددا كثيرا وجما غفيرا ، امتحنهم بأمر الله ليتبين الثابت المطمئن ممن ليس كذلك فقال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فهو عاص ولا يتبعنا لعدم صبره وثباته ولمعصيته ومن لم يطعمه - أي: لم يشرب منه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فلا جناح عليه في ذلك، ولعل الله أن يجعل فيها بركة فتكفيه، وفي هذا الابتلاء ما يدل على أن الماء قد قل عليهم ليتحقق الامتحان، فعصى أكثرهم وشربوا من النهر الشرب المنهي عنه، ورجعوا على أعقابهم ونكصوا عن قتال عدوهم وكان في عدم صبرهم عن الماء ساعة واحدة أكبر دليل على عدم صبرهم على القتال الذي سيتطاول وتحصل فيه المشقة الكبيرة، وكان في رجوعهم عن باقي العسكر ما يزداد به الثابتون توكلا على الله، وتضرعًا واستكانة وتبرؤا من حولهم وقوتهم، وزيادة صبر لقلتهم وكثرة عدوهم، فلهذا قال تعالى: فلما جاوزه - أي: النهر هو - أي: طالوت والذين آمنوا معه وهم الذين أطاعوا أمر الله ولم يشربوا من النهر الشرب المنهي عنه فرأوا قلتهم وكثرة أعدائهم، قالوا- أي: قال كثير منهم لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده لكثرتهم وعَددهم وعُددهم قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله - أي: يستيقنون ذلك، وهم أهل الإيمان الثابت واليقين الراسخ، مثبتين لباقيهم ومطمئنين لخواطرهم، وآمرين لهم بالصبر كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله - أي: بإرادته ومشيئته فالأمر لله تعالى، والعزيز من أعزه الله، والذليل من أذله الله، فلا تغني الكثرة مع خذلانه، ولا تضر القلة مع نصره، والله مع الصابرين بالنصر والمعونة والتوفيق، فأعظم جالب لمعونة الله صبر العبد لله، فوقعت موعظته في قلوبهم وأثرت معهم.تفسير السعدي. "وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ". 250. وقوله: بَرَزُوا أى صاروا إلى براز الأرض وهو ما انكشف منها بحيث يصير كل فريق من المتقاتلين يرى صاحبه، ومنه سميت المبارزة في الحرب لظهور كل قرن إلى قرنه. أي: وحين برز طالوت ومن معه لقتال جالوت وجنوده، وأصبح الفريقان في مكان متسع من الأرض بحيث يرى كلُّ فريقٍ خصمَهُ اتجه المؤمنون إلى الله-تبارك وتعالى- بالدعاء قائلين بإخلاص وخشوع:رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْرًاأي: أنزل وأصبب وأفض علينا أتم الصبر ليعمنا، ويملأ قلوبنَا ثقة بنصرك، ويحبس نفوسَنا على طاعتك. وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ:أىي هب لنا من كمال القوة والرسوخ عند القتال ما يجعلنا نثبت أمام أعدائِنا، ونتمكن من رقابهم دون أن يتمكنوا منا. فهذا الدعاء كناية عن أن يمنحهم- سبحانه - الثبات عند الزحف، وعدم الفرار عند القتال. وفي قوله: وَثَبِّتْ أَقْدامَنا: تعبير بالجزء عن الكل، لأن الأقدام هي التي يكون بها الفرار، فتثبيتها إبعاد عن الفرار، ومتى حصل الثبات كان النصر متوقعًا، والصبر متحققًا. ثم ختموا دعاءهم بأن قالوا:وَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ: أي اجعل الغلبة لنا عليهم، لأننا مؤمنون بأنك المعبود المستحق للعبادة وهم يكفرون بذلك. والمتأمل في هذه الدعوات الثلاث يراها قد جمعت أسمى ألوان الأدب وحسن الترتيب، فهم قد صدروا دعاءهم بالتوسل بوصف الربوبية فقالوا رَبَّنا أى يا خالقنا ويا منشئنا ويا مربينا ويا مميتنا، وفي ذلك إشعار أنهم يلجئون إلى من بيده وحده النفع والضر، والنصر والهزيمة. ثم افتتحوا دعاءهم بطلب الصبر عند المخاوف لأنه هو عُدة القتال الأُولى، وركنُه الأعلى، إذ به يكون ضبط النفس فلا تفزع، وبه يسكن القلب فلا يجزع. ثم التمسوا منه- سبحانه - أن يثبت أقدامهم عند اللقاء لأن هذا الثبات هو مظهر الصبر، ووسيلة النصر، وعنوان القوة. ثم ختموا دعاءهم بما هو ثمرة ونتيجة للصبر والثبات وهو النصر على الأعداء. "فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ" 251. أي : فغلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم. والفاء هنا فصيحة أو سببية أي أنهم بسبب دعائهم المخلص، وإيمانهم القوي، واستجابتهم لما أمرهم الله به، استطاعوا أن يكسروا أعداءهم ويهزموهم، وقوله: بِإِذْنِ اللَّهِ :أي بتوفيقه وتيسيره وتأييده. وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوت:وقتل داوود بن إيشا - وكان في جيش طالوت- جالوت الذي كان يقود جيش الكفر، وبقتله مزق أتباعه شر ممزق، ورزق الله طالوت ومن معه النصر والغلبة. ثم بيَّنَ- سبحانه - ما منحه لداوود من نعم فقال: وَآتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشاءُ: والحكمة المراد بها هنا النبوة، ولم يجتمع المُلك والنبوة لأحد قبله في بنى إسرائيل، وورثه فيهما ابنه سليمان- عليه السلام-. أي: وأعطى الله-تبارك وتعالى- عبده داوود مُلك بني إسرائيل وأعطاه النبوة التي هي أشرف من المُلْك زيادة في ترقيته في درجات الشرف والكمال، وعلمه- سبحانه - مما يشاء من فنون العلم، ومن أمور الدين والدنيا كمعرفته لغة الطيور، وكلام الدواب، وصناعة آلات الحرب وغير ذلك من ألوان العلوم المختلفة التي لا تحدها إلا مشيئة الله وإرادته. قال تعالى "وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَعِلِينَ " الأنبياء: 79. "وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَاجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ * أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ " سبأ: 10، 11. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ: أي: ولولا أن الله-تبارك وتعالى- يدفع أهل الباطل بأهل الحق، لفسدت الأرض، وعمها الخراب لأن أهل الفساد إذا تركوا من غير أن يقاوموا استطارت شرورهم، وتغلبوا على أهل الصلاح والاستقامة، وتعطلت مصالح الناس، وانتشر الفساد في الأرض. فلولا في الجملة الكريمة حرف امتناع لوجود. أى: امتنع فساد الأرض لأجل وجود دفع الناس بعضهم ببعض. فالجملة الكريمة تأمر الأخيار في كل زمان ومكان أن يقفوا في وجوه الأشرار، وأن يقاوموهم بكل وسيلة من شأنها أن تحول بينهم وبين الفساد والطغيان. ثم ختم- سبحانه - الآية بقوله: وَلكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعالَمِينَ. أي: ولكن الله-تبارك وتعالى- صاحب فضل عظيم، وإنعام كبير على الناس أجمعين، لأنه وضع لهم هذا التنظيم الحكيم الذي أوجب فيه على المصلحين أن يدافعوا المفسدين، وأن يقاوموهم بالطريقة التي تمنع فسادَهم حتى ولو أدى ذلك إلى رفع السلاح في وجوهِهم، لأن السكوت عن فساد المفسدين سيؤدي إلى العقاب الذي يعمهم ويصيب معهم المصلحين. "اسْتَيْقَظَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِنَ النَّوْمِ مُحْمَرًّا وجْهُهُ يقولُ: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، ويْلٌ لِلْعَرَبِ مِن شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ اليومَ مِن رَدْمِ يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ مِثْلُ هذِه وعَقَدَ سُفْيَانُ تِسْعِينَ أوْ مِئَةً قيلَ: أنَهْلِكُ وفينَا الصَّالِحُونَ؟ قالَ: نَعَمْ، إذَا كَثُرَ الخَبَثُ." الراوي : زينب أم المؤمنين - صحيح البخاري . والخَبَثُ: هو الفُسوقُ والفجورُ والمعاصي، مِن نَحوِ الزِّنا، والخُمورِ، وغَيرِها، وإذا كَثُرَ المُجترِئونَ على مَعاصي اللهِ دونَ رادعٍ ولا وازعٍ؛ عَمَّ الهلاكُ الجَميعَ، ثُمَّ يُبعَثُ كلٌّ على نيَّتِه. قال تعالَى " وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً" الأنفال: 25. وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغير، فإن عقوبته تعم الفاعل وغيره، وتقوى هذه الفتنة بالنهي عن المنكر، وقمع أهل الشر والفساد، وأن لا يُمَكَّنُوا من المعاصي والظلم مهما أمكن.
|
|
|

|
|
|
#3 |
|
نفع الله بك الأمة
|
من آية 252إلى آية254 . " تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ " 252. تِلْكَ آياتُ اللَّهِ : أي هذه القصص السالفة من حديث الألوف الذين خرجوا من ديارهم، وتمليك طالوت، وإتيان التابوت، وانهزام الجبابرة، وقتل داود جالوت - آيات الله نقصها عليك على وجه لا يشك فيه أهل الكتاب، إذ هم يجدونه مطابقًا لما جاء في كتبهم الدينية والتاريخية فأنت من المرسلين لما دلت عليه هذه الآيات، ولو كنت قد تعلمتها لجئت بها على النهج الذي عند أهل الكتاب أو غيرهم من القصّاص، ولم تشاهد أزمنة وقوعها حتى تراها رأي العين، وقد أشار سبحانه إلى مثل هذه الحجة للدلالة على نبوّته صلى الله عليه وسلم- وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ .تفسير المراغي. أي: تلك الآيات التي حدثناك فيها عن قصة أولئك القوم وما جرى لهم هي آيات الله التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، نتلوها عليك يا محمد عن طريق جبريل الأمين تلاوة ملتبسة بالحق الثابت الذي لا يحوم حوله الباطل، وإنك يا محمد لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ الذين أرسلهم الله-تبارك وتعالى- بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. فالإشارة في قوله تِلْكَ آياتُ اللَّهِ إلى الآيات المتلوة من قوله-تبارك وتعالى:أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَإلى آخر القصة. وقيل إليها وإلى القصة التي قبلها وهي قصة القوم الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ. تِلْكَ :وكانت الإشارة للبعيد، لما في ذلك من معنى الاستقصاء للآيات – الاستقصاء هو البحثُ العميقُ والتَّحليلُ المكثَّف لمعطياتٍ معيَّنةٍ متعلقةٍ بمسألةٍ ما ، ولعلو شأنها، وكمال معانيها، والوفاء في مقاصدها. آياتُ اللَّهِ :وأضيفت الآيات إلى الله لأنها جزء من هذا القرآن الذي أنزله- سبحانه - على نبيه محمد صلّى الله عليه وسلّم ليكون هداية للناس، وليحملهم على تدبرها والاعتبار بها لأنها من عند الله الذي شرع لهم ما يسعدهم. وجعل- سبحانه - تلاوة جبريل للقرآن تلاوة له فقال: نَتْلُوها عَلَيْكَ.للإشعار بشرف جبريل، وأنه ما خرج في تلاوته عما أمره الله به، فهو رسوله الأمين إلى رسله المكرمين. بِالْحَقِّ: أي ملتبسة باليقين الذي لا يرتاب فيه عاقل.التفسير الوسيط. وبعد أن شهد الله-تبارك وتعالى- لنبيه محمد صلّى الله عليه وسلّم بأنه من المرسلين الذين أرسلوا لينصروا الحق، وليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، بعد كل ذلك بين الله- تعالى أن الرسل وإن كانوا قد بعثوا جميعا لهداية البشر إلا أنهم يتفاضلون فيما بينهم فقال-تبارك وتعالى-: "تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۘ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ" 253. "تِلْكَ " الإشارة باللفظ الدال على البعيد، لبيان سمو مكانة الرسل- عليهم الصلاة والسلام- وأنهم هم المصطفون الأخيار. أي هؤلاء الرسل المشار إليهم بقوله" وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ" فضلنا بعضهم على بعض في مراتب الكمال، مع استوائهم جميعًا في اختياره تعالى لهم كرسل للتبليغ عنه وهداية خلقه إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. ثم بين- سبحانه - بعض مظاهر التفضيل فقال: مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ أي منهم من فضله الله بتكليمه إياه كموسى- عليه السلام- فقد وردت آيات صريحه في ذلك، منها قوله-تبارك وتعالى" وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسى تَكْلِيمًا"النساء:164.وقوله-تبارك وتعالى" قالَ يا مُوسى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسالاتِي وَبِكَلامِي" الأعراف :144..وقوله-تبارك وتعالى"وَلَمَّا جاءَ مُوسى لِمِيقاتِنا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ". الأعراف :143. ثم قال- سبحانه: وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ :أي: ومنهم من رفعه الله على غيره من الرسل مراتب سامية ومنازل عالية. قيل كإبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، وإدريس الذي رفعه الله مكانا عليا، وداود الذي آتاه الله النبوة والملك. والذي عليه المحققون من العلماء والمفسرين أن المقصود بقوله-تبارك وتعالى- وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ هو سيدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم - الذي اجتمع فيه من الفضائل ما تفرق في غيره، وجمع الله له من المناقب ما فاق به الأولين والآخرين.و هو صاحب الدرجات الرفيعة والمعجزة الخالدة الباقية إلى يوم القيامة والرسالة العامة الناسخة لكل الرسالات قبلها. ولو لم يؤت إلا القرآن وحده لكفى به فضلًا منيفًا على سائر ما أوتي الأنبياء، لأنه المعجزة الباقية على وجه الدهر دون سائر المعجزات. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ : الْبَيِّناتِ: هي المعجزات الظاهرة البينة. بِرُوحِ الْقُدُسِ :هو جبريل- عليه السلام والمعنى: وأعطينا عيسى بن مريم الآيات الباهرات، والمعجزات الواضحات كإبراءِ الأكْمَه والأبْرَص، وإحياء الموتى، وإخبار قومه بما يأكلونه ويدخرونه في بيوتهم، وفضلا عن هذا فقد أيده بجبريل عليه السلام يلازمه في أحواله .قال شيخ الإسلام ابن تيمية : قال جماهير العلماء إنه جبريل عليه السلام فإن الله سماه الروح الأمين وسماه روح القدس وسماه جبريل . دقائق التفسير ج: 1 ص: 310. قال الزمخشري: فإن قلت لم خُص موسى وعيسى من بين الأنبياء بالذكر؟ قلت: لمِا أُوتِيَا من الآيات العظيمة والمعجزات الباهرة ولقد بين الله وجه التفضيل حيث جعل التكليم من الفضل وهو آية من الآيات. لما كان هذان النبيان قد أوتيا ما أوتيا من عظام الآيات خصا بالذكر في باب التفضيل.هذا دليل بين على أن من زيد تفضيلا بالآيات منهم فقد فُضِّلَ على غيره. ولما كان نبينا محمد صلّى الله عليه وسلّم هو الذي أوتي منها ما لم يؤت أحد في كثرتها وعظمها كان هو المشهود له بإحراز قصبات الفضل غير مدافع.ا.هـ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ: أي: ولو شاء الله-تبارك وتعالى- ألا يقتتل الذين جاءوا بعد كل رسول من الرسل وبعد أن جاءهم الرسل بالبينات الدالة على الحق، لو شاء الله ذلك لفعل، ولكن الله-تبارك وتعالى- لم يشأ ذلك، لأنه خلق الناس مختلفين في تقبلهم للحق، فترتب على هذا الاختلاف أن آمن بالحق الذي جاءت به الرسل من فتح له قلبه، واتجه إليه اختياره، وأن كفر به من آثَرَ الضلالةَ على الهدايةِ واستحب العمى على الهدى، وترتب عليه- أيضًا أن تقاتل الناس وتحاربوا. "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ" 254. وهذا من لطف الله بعباده أن أمرهم بتقديم شيء مما رزقهم الله، من صدقة واجبة ومستحبة، ليكون لهم ذُخرًا وأجرًا موفرًا في يوم يحتاج فيه العاملون إلى مثقال ذرة من الخير، فلا بيع فيه ولو افتدى الإنسان نفسه بملء الأرض ذهبا ليفتدي به من عذاب يوم القيامة ما تُقبل منه، ، ولا يكون فيه صديق يدفع عنكم، ولا شفيع يشفع لكم فيحط من سيئاتكم إلا أن يأذن رب العالمين بالشفاعة تفضلا منه وكرمًا. وبذلك نرى أن الآية الكريمة قد حضت المؤمنين على المسارعة في إنفاق أموالهم في وجوه الخير من قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه ما كان نافعًا في الدنيا من أقوال وأعمال وأنها قد توعدت من يبخل عن الإنفاق في سبيل الله بسوء العاقبة، لأنه تشبه بالكافرين في بخلهم وإمساكهم عن بذل أموالهم في وجوه الخير. وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ:أي : ولا ظالم أظلم ممن وافى الله يومئذ كافرا . وهو اليوم الذي فيه يخسر المبطلون ويحصل الخزي على الظالمين، وهم الذين وضعوا الشيء في غير موضعه، فتركوا الواجب من حق الله وحق عباده وتعدوا الحلال إلى الحرام، وأعظم أنواع الظلم الكفر بالله الذي هو وضع العبادة التي يتعين أن تكون لله فيصرفها الكافر إلى مخلوق مثله، فلهذا قال تعالى: والكافرون هم الظالمون وهذا من باب الحصر،- أي: الذين ثبت لهم الظلم التام، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم.
|
|
|

|
|
|
#4 |
|
نفع الله بك الأمة
|
آية: 255 "اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَوَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ العظيم" الْعَظِيمُ255" مُناسبة الآية لِمَا قبلها: لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تعالى أنَّ الكافرين هم الظَّالمون،فالكفر أعظم الظلم ، في المقابل ذَكَرَ بعدها أعظم آية في كتاب الله، هذه الآية العظيمة الدَّالة على إفراد الله بالوحدانيَّة، المتضمِّنة لأصول صفاتِه العُلا، والعقيدةِ الصَّحيحةِ التي هي مَحْض التَّوحيد، وتضمنت هذه الآية العظيمة الدلائل على أحقيته سبحانه وتعالى بالتوحيد. قال النووي "قال العلماء: إنما تميزت آية الكرسي بكونها أعظم آية لما جمعت من أصول الأسماء والصفات من الإلهية والوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة والإرادة".ا.هـ. ومن تأمل هذه الآية وتدبرها ظهر له من هذه المعاني ما يُعرّفه بقدر هذه الآية، وفضلها وعلوّ منزلتها، فحريّ بكل مسلم أن يتعلمها ويحفظها ، ويتدبر معناها ، ويعمل بمقتضاها، ويحافظ على قراءتها في مواطنها كي ينعم بفضلها. فضل ومواطن قراءة آية الكرسي: "يا أبا المُنْذِرِ، أتَدْرِي أيُّ آيَةٍ مِن كِتابِ اللهِ معكَ أعْظَمُ؟ قالَ: قُلتُ: اللَّهُ ورَسولُهُ أعْلَمُ. قالَ: يا أبا المُنْذِرِ أتَدْرِي أيُّ آيَةٍ مِن كِتابِ اللهِ معكَ أعْظَمُ؟ قالَ: قُلتُ"اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ"البقرة: 255.قالَ: فَضَرَبَ في صَدْرِي، وقالَ: واللَّهِ لِيَهْنِكَ العِلْمُ أبا المُنْذِرِ."الراوي : أُبي بن كعب - صحيح مسلم. شرح الحديث: أتَدْرِي أيُّ آيَةٍ مِن كِتابِ اللهِ معكَ أعْظَمُ؟: أي أعظم : في الأجرِ والنَّفعِ لصاحبِها في الدُّنيا والآخِرةِ. قالَ: قُلتُ: اللَّهُ ورَسولُهُ أعْلَمُ: وهذا مِن حُسنِ أدبِ الصَّحابةِ رَضِي اللهُ عنهم مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، وقدْ قيل: كان أُبَيٌّ يَعلَمُ أيُّ آيةٍ أعظَمُ حِينَ سَألَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن ذلك، ولكنْ لم يُجِبْهُ؛ تَعظيمًا وتَواضُعًا له صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، وتأدُّبًا معه؛ فإنَّه لو أجابَه أوَّلَ ما سَأله لكانَ إظهارًا لعِلمِه. ويَحتمِلُ أنَّه سكَت عن الجوابِ؛ لتَوقُّعِ أنْ يُخبِرَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أنَّ آيةً أُخرى أعظَمُ منها، أو يُخبِرَه بفائدةٍ ما، فلمَّا كرَّر النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم السُّؤالَ عَلِم أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يُطالِبُه بالجَوابِ، ويُريدُ امتحانَ حِفظِه ودِرايتِه، فأجابه بأنَّ أفضَلَ آيةٍ -على حدِّ عِلمِه- هي قولُ اللهِ تعالَى "اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ....." فأقَرَّه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم على إجابتِه وأنَّها صَحيحةٌ، وضرَبَ بيَدِه الشَّريفةِ على صدْرِ أُبيٍّ رَضِي اللهُ عنه، وهذا الفِعلُ مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم مِن التَّلطُّفِ؛ لرِضاهُ بهذه الإجابةِ، ومُوافقَتِه عليها، مع إعجابِه بالمُجيبِ، وقالَ له"واللهِ لِيَهْنِكَ العِلمُ أبا المُنذرِ"، أيْ: لِيَكُنِ العلمُ هَنيئًا لك تَهنَأُ به، والقَصدُ الدُّعاءُ لَه بتَيسيرِ العِلمِ والرُّسوخِ فيهِ. الدرر السنية. "مَن قرأَ آيةَ الكُرسيِّ في دبُرِ كلِّ صلاةٍ مَكْتوبةٍ لم يمنَعهُ مِن دخولِ الجنَّةِ إلَّا أن يموتَ"الراوي : أبو أمامة الباهلي - المحدث : الوادعي - المصدر : الصحيح المسند . لم يمنَعهُ مِن دخولِ الجنَّةِ إلَّا أن يموتَ: أي: أن الموت يكون هو الحاجز بينه وبين دخول الجنة، فإذا انقضى هذا الحاجز -الموت- حصل دخول الجنة. وهذا يدل على أن من أراد أيضًا أن يختم له بخير فليحرص على آية الكرسي دبر الصلاة المكتوبة. آية الكرسي من أعظم ما يحصن العبد من الشياطين-بإذن الله- ، فليس أشد شيء على الشياطين من آية الكرسي:يقول أبو هريرة: وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ "وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ: وَاللَّهِ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: إِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَىَّ عِيَالٌ، وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ. قَالَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ. فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالاً، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ. فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّهُ سَيَعُودُ، فَرَصَدْتُهُ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. قَالَ: دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَىَّ عِيَالٌ، لاَ أَعُودُ، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ؟قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالاً، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ. فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهَذَا آخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ، أَنَّكَ تَزْعُمُ لاَ تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ. قَالَ: دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا. قُلْتُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ "اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ"حَتَّىتَخْتِمَ الآيَةَ فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ: مَا هِيَ؟قُلْتُ: قَالَ لِي إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ "اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ" وَقَالَلِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، وَكَانُوا أَحْرَصَ شَىْءٍ عَلَى الْخَيْرِ. فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟قَالَ: لاَ.قَالَ: ذَاكَ شَيْطَانٌ".صحيح البخاري. الحديث 2311 - طرفاه في: 3275، 5010 . حديث مُعَلَّق .ووصله النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق إلى عثمان. قال الحافظ ابن حجر: والمراد بالتعليق ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، ولو إلى آخر الإسناد، وتارة يجزم به كـ "قال"، وتارة لا يجزم به -أي بصيغة التمريض - كـ "يذكر". تفسير آية الكرسي : اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ: الإِلَهِيَّةُ والأُلُوهِيَّةُ صِفةٌ ثابتةٌ للهِ عزَّ وجلَّ، مِن اسمِه: اللهِ، واسمِه: الإِلَهِ، وهما اسمانِ ثابتانِ في مواضِعَ عديدةٍ مِن كِتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ.قال السَّعْديُّ في تفسيره : اللهُ: هو المألوهُ المعبودُ ذو الأُلوهيَّةِ والعُبوديَّةِ على خَلْقِه أجمعينَ؛ لِمَا اتَّصَفَ به مِن صِفات الأُلوهيَّةِ الَّتي هي صِفاتُ الكَمالِ. في الآيةإخبار بأنه المتفرد سبحانه بالإلهية لجميع الخلائق والإلهية في اللغة هي العبادة على المشهور، الله هو المعبود بحق، لا معبود بحق سواه ، فهو الإله الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة والتأله له تعالى، لكمالِهِ وكمال صفاته وعظيم نعمه، ولكون العبد مستحقا أن يكون عبدًا لربه، ممتثلا أوامره مجتنبًا نواهيه، وكل ما سوى الله تعالى باطل، فعبادة ما سواه باطلة. والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولا يكون العمل عبادة إلا إذا كان مأمورًا به من الشارع الحكيم سبحانه وتعالى على لسانِ رسولِهِ صلى الله عليه وسلم ، فالله لا يحب ولا يرضى إلا ما أمر به، والشيء الذي لم يأمر الله جل وعلا به لا يكون عبادة، فلا يتعبد الإنسان برأيه أو بنظره وقياسه، وإن كان هذا العمل عبادة في اللغة، ولكنه في الشرع ليس عبادة. فالعبادة في الشرع لابد أن يجتمع فيها أمران: أحدهما: أن تكون خالصة لله.والثاني: أن تكون هذه العبادة صوابًا وَالصَّوابُ أَنْ يَكُونَ عَلَى السُّنَّةِ أي جاء بها نص صحيح الثبوت والدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها سواء من القرآن أو السنة الصحيحة. الْحَيُّ : هو الحي في نفسه حياة أزلية أبدية لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، أي واجب الوجود، فهو سبحانه الْحَيُّ أي الباقي الذي له الحياة الدائمة التي لا فناء لها ، وسائر الأحياء سواه – ممكنة الوجود - يعتريهم الموت والفناء. والْقَيُّومُ مأخوذ من القيام، ومعناه : أنه جل جلاله القائم بنفْسه الذي لا يَحتاج لأحدٍ، والقائمُ بتدبير أمر الخلق وحفظهم، والمعطي لهم ما به قوامهم من رزقٍ ورعاية وحفظ، وما من شيء إلا وإقامته بأمره وتدبيره سبحانه وتعالى. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى "الْحَيُّ"كمال الأوصاف، و "الْقَيُّومُ " تعبير عن كمال الأفعال. لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ:في قوله: لَا تَأْخُذُهُ دَِلالة على أن للنوم قوة قاهرة تأخذ المخلوق أخذًا وتقهر الكثير من أجناس المخلوقات قهرًا، ولكنه- سبحانه - وهو القاهر فوق عباده- منزه عن ذلك، ومُبَرأ من أن يعتريه ما يعتري الحوادث – أي المخلوقات-. وكلاهما ينافي كمال القدرة والحياة ،ومن تمام حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سِنة ولا نوم.أَيْ: لَا تَغْلِبُهُ سِنَةٌ وَهِيَ الْوَسَنُ وَالنُّعَاسُ والوسن مقدمة النوم والفتور الذي يكون في أول النوم مع بقاء الشعور والإدراك.ويقال له غَفْوَة. وَلِهَذَا قَالَ" وَلَا نَوْمٌ " لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنَ السِّنَةِ ، وتقديم السِّنة على النوم يفيد المبالغة من حيث إن نفي السِّنَة يدل على نفي النوم بالأولى ،أي لَا يَعْتَرِيهِ نَقْصٌ وَلَا غَفْلَةٌ وَلَا ذُهُولٌ عَنْ خَلْقِهِ بَلْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ شَهِيدٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَا يَغِيبُ عَنْهُ شَيْءٌ وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ ، وَمِنْ تَمَامِ الْقَيُّومِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَعْتَرِيهِ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. " قامَ فِينا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ بأَرْبَعٍ: إنَّ اللَّهَ لا يَنامُ ولا يَنْبَغِي له أنْ يَنامَ، يَرْفَعُ القِسْطَ ويَخْفِضُهُ، ويُرْفَعُ إلَيْهِ عَمَلُ النَّهارِ باللَّيْلِ، وعَمَلُ اللَّيْلِ بالنَّهارِ".الراوي : أبو موسى الأشعري - صحيح مسلم. لا يَنامُ ولا يَنْبَغِي له أنْ يَنامَ: اللهَ عزَّ وجلَّ لا يَأتيه النَّومُ، فهو دائمُ اليَقَظةِ، ولا يَليقُ به سُبحانَه جَلَّ شَأنُه أن يَنامَ؛ فإنَّ النَّومَ مُستحيلٌ في حقِّه جلَّ شأنُه؛ لأنَّ النَّومَ صِفَةُ نَقصٍ، ويَستَحيلُ على اللهِ عزَّ وجلَّ أن يكونَ به نَقصٌ، وكيفَ يَنامُ مُدبِّرُ السَّمواتِ والأرضِ؟! يَرْفَعُ القِسْطَ ويَخْفِضُهُ:اللهَ عزَّ وجلَّ يَملِكُ بيَدِه القِسطَ، وهو ميزانُ العدلِ والأرزاقِ الَّذي يَعدِلُ به بينَ عِبادِه فيُضيِّقُ ويُوسِّعُ عليهم؛ لِحكمةٍ عندَه سُبحانَه وتعالَى، وسُمِّيَ قِسطًا لأنَّ القِسطَ العَدلُ، وبالميزانِ يَقَعُ العدلُ، والمُرادُ أنَّ اللهَ تَعالَى يَخفِضُ الميزانَ ويَرفعُه بما يُوزَنُ من أعمالِ العِبادِ المُرتفِعةِ، ويُوزَنُ من أرزاقِهمُ النَّازِلةِ، وقيلَ: المُرادُ بالقِسطِ الرِّزقُ الذي هو قِسطُ كلِّ مخلوقٍ؛ يَخفِضُه فيَقتُرُه، ويَرفَعُه فيُوسِعُه. لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ : تقرير لانفراده بالألوهية إذ جميع الموجودات مخلوقاته خاضعون لمشيئته ، وتعليل لاتصافه بالقيومية، لأن من كانت جميع الموجودات ملكًا له فهو حقيق بأن يكون قائمًا بتدبير أمرها.وتفيد الملكية المطلقة لرب العالمين لكل ما في هذا الوجود من شمس وقمر وحيوان ونبات وجماد وغير ذلك من المخلوقات. وصُدرت الجملة بالجار والمجرور " لَّهُ " لإفادة القصر أي ملك السموات والأرض له وحده ليس لأحد سواه شيء معه. مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ: الشفاعة في الاصطلاح: هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، فمثلًا: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يُقْضَى بينهم: هذه شفاعة بدفع مضرة، وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها هذه شفاعة بجلب منفعة. والاستفهام هنا للنفي والإنكار أي: لا أحد يستطيع أن يشفع عنده- سبحانه - إلا بإذنه ورضاه قال-تبارك وتعالى"وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّماواتِ لا تُغْنِي شَفاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشاءُ وَيَرْضى"النجم: 26. وهذا تمثيل لانفراده بالملك والسلطان في ذلك اليوم، وأن أحدًا من عباده لا يجرؤ على الشفاعة أو التكلم بدون إذنه. وفي ذلك تيئيس للكفار حيث زعموا أن آلهتهم شفعاء لهم عند الله". قال تعالى "يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ " غافر : 16. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ :تأكيد لكمال سلطانه في هذا الوجود، وبيان لشمول علمه على كل شيء. أي أن علمه محيط بجميع خلقه، فلا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض. يعلم ما بين أيديهم - أي: ما مضى من جميع الأمور وما خلفهم - أي: ما يستقبل منها، فعلمه تعالى محيط بتفاصيل الأمور، متقدمها ومتأخرها، بالظواهر والبواطن، بالغيب والشهادة، والعباد ليس لهم من الأمر شيء ولا من العلم مثقال ذرة إلا ما علمهم تعالى. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ: عن ابنِ عباسٍ في قولِه تعالى"وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ" "الكرسيُّ موضعُ القدمين ، والعرشُ لا يقدرُ قدرَه إلا اللهُ تعالى"الراوي : سعيد بن جبير- المحدث : الألباني - المصدر : شرح الطحاوية- الصفحة أو الرقم : 279 - خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوف . أهْلُ السُّنَّةِ والجَماعةِ يُثبِتونَ للهِ ما جاء في القُرآنِ والسُّنَّةِ الصَّحيحةِ؛ ومِن ذلك صِفاتُه جلَّ وعلا.وفي هذا الأثَرِ يَرْوي التَّابِعيُّ سَعيدُ بنُ جُبَيرٍ، عن عَبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما في قولِه تعالى"وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ" البقرة: 255؛ أنَّ الكُرْسيَّ هو مَوضِعُ القَدَمينِ؛ لأنَّ الكُرْسيَّ أكبَرُ مِن السَّمَواتِ والأرْضِ، فكيْف بعَظَمةِ خالِقِ الكُرْسيِّ، ومُوجِدِه ومُبدِعِه؟! وعلى هذا درَج أهْلُ السُّنَّةِ، والواجِبُ إثْباتُ ما أثبَتَه اللهُ لنفْسِه مِنَ اليَدَينِ والقَدَمَينِ والأصابِعِ وغَيرِها منَ الصِّفاتِ الوارِدةِ في الكِتابِ والسُّنَّةِ على الوَجهِ اللَّائقِ باللهِ سُبحانَه، من غيرِ تَحريفٍ، ولا تَكْييفٍ، ولا تَمْثيلٍ، ولا تَعْطيلٍ. وعَرشُ الرَّحمنِ هو الَّذي اسْتَوى عليه اللهُ جلَّ جَلالُه، وهو أعْلى المَخْلوقاتِ وأكبَرُها، وصَفَه اللهُ بأنَّه عَظيمٌ، وبأنَّه كَريمٌ، وبأنَّه مَجيدٌ، وهو غَيرُ الكُرسيِّ الَّذي هو مَوضِعُ قدَمَيْه، كما تَقدَّمَ.الدرر السنية. "ما السَّماوات السّبع في الكُرسيِّ إلَّا كحلقةٍ ملقاةٍ بأرضٍ فلاةٍ ، وفضلُ العرشِ على الكُرسيِّ كفضلِ تلك الفلاةِ على تلك الحلقةِ" الراوي : أبو ذر الغفاري - المحدث : الألباني - المصدر : التعليق على الطحاوية- الصفحة أو الرقم : 36 - خلاصة حكم المحدث : هذا القدر فقط صح مرفوعًا . وَالْكُرْسِيُّ مَخْلُوقٌ عَظِيمٌ بَيْنَ يَدَيِ الْعَرْشِ، وَهُوَ أَعْظَمُ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، نُفَوِّضُ عِلْمَ حَقِيقَتِهِ إِلَيْهِ -تَعَالَى-. إذا كان هذه حالة الكرسي أنه يسع السماوات والأرض على عظمتهما وعظمة من فيهما، والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى، بل هناك ما هو أعظم منه وهو العرش، وما لا يعلمه إلا هو سبحانه ، وفي عظمة هذه المخلوقات تتحير الأفكار وتكل الأبصار، وتقلقل الجبال ....، فكيف بعظمة خالقها ومبدعها، والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع، والذي قد أمسك السماوات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصب، فلهذا قال: وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا :أي: لا يُثقِله ولا يَشقُّ عليه حِفْظ السَّموات والأرض ومن فيهما ومن بينهما. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ : أما العلي فهو من العلو المطلق، وفي العلو تنزيه ، ولا يكون عليا إلا لأنه عظيمًا،العلي لكمال قوته وقدرته وسلطانه وعظمته، العلي بذاته -جل وعلا- على جميع المخلوقات، العلي بعظيم الصفات، العليّ الذي قهر جميع المخلوقات، ودانت له الموجودات، وخضعت لقدرته الصعاب وذلت له الرقاب. ، العلي بقَدْرِهِ لكمال صفاته. العلي بذاته فوق عرشه. الْعَظِيمُ : والله سبحانه هو العظيم العظمة المطلقة من جميع الوجوه ؛ فهو عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه كلها، عظيم في صفاته كلها، فهو عظيم في سمعه وبصره، عظيم في قُدْرَتِهِ وقوتِهِ، عظيم في علمِهِ.العظيم الذي تتضائل عند عظمته جبروت الجبابرة، وتصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة، فسبحان من له العظمة والكبرياء والقهر والغلبة لكل شيء. "قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ : الكبرياءُ ردائي ، والعظمةُ إزاري ، فمَن نازعَني واحدًا منهُما ، قذفتُهُ في النَّارِ"الراوي : أبو هريرة -المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود -الصفحة أو الرقم : 4090 - خلاصة حكم المحدث : صحيح. الكِبرياءُ والعَظمةُ وما يُقارِبُهما مِن المعانِي مِن الصِّفاتِ التي اختصَّ المولى عزَّ وجلَّ بها نفْسَه عن سائرِ الخلقِ، وهي في حَقِّه سبحانَه صفاتُ كمالٍ، وأمَّا في حقِّ الخَلقِ فهي صفةُ نقْصٍ. ووصْفُ اللهِ تَعالى بأنَّ العَظَمَة إزارُه والكبرياءَ رِداؤُه كسائرِ صِفاته؛ تُثبَت على حقيقتها على ما يَليقُ به سبحانَه، والواجبُ الإيمانُ بها وإمرارُها كما جاءتْ؛ دونَ تَحريفٍ ولا تَعطيلٍ، ودون تَكييفٍ أو تمثيلٍ.أي نثبت ونؤمن أن لها كيف لكن لا نعلمه لذا نفوض الكيف لعلمه سبحانه وتعالى عما يصفون أي تنزه عن الصفات الدنيا. العلي لكمال قوته وقدرته وسلطانه وعظمته، العلي بذاته -جل وعلا- على جميع المخلوقات، العلي بعظيم الصفات، العليّ الذي قهر جميع المخلوقات، ودانت له الموجودات، وخضعت لقدرته الصعاب وذلت له الرقاب. خلاصة تفسير هذه الآية : هذه الآية تملأ القلب مهابة من الله وعظمته وجلاله وكماله، واشتملت هذه الآية على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته. فهي تدل على أن الله تعالى متفرد بالألوهية والسلطان والقدرة، قائم على تدبير الكائنات في كل لحظة لأنه القيوم، لا يغفل عن شيء من أمور خلقه ولا تأخذه عن خلقه سِنَة ولا نوم ، وهو مالك كل شيء في السموات والأرض، لا يجرأ أحد على شفاعة لأحد إلا بإذنه، ويعلم كل شيء في الوجود، ويحيط علمه بكل الأمور وأوضاع الخلائق دقيقها وعظيمها،، والعباد ليس لهم من العلم مثقال ذرة إلا ما علمهم تعالى، ومن دلائل عظمته أن كرسيه وسع السموات والأرض فكيف بعظمة خالقه ومبدعه ، هو العلي الشأن، القاهر الذي لا يُغلب، العظيم الملك والقدرة على كل شيء سواه، فلا موضع للغرور، ولا محل لعظمة أمام عظمة الله تعالى. توحيد الألوهية" اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو" قوله"لَّهُ مَا فِي السَّمَواتِ ومَا فِي الأَرْضِ" هذا إثبات لربوبيته، فهو مالك السماوات والأرض ومن فيهن. توحيد الأسماء والصفات " اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ "وهذا فيه إثبات لفظ الجلالة الله اسم من أسماء الله الحسنى. واسم الحي واسم القيوم، وما يشتق منها من أوصاف، الحياة والقيومية لله. "وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ"إثبات لاسمه العلي واسمه العظيم .وقوله" لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ " هذا نفي، نفى اللهُ عن نفسِهِ النقص والعيب، فمن صفات النقص المنفية المثبتة لكمال الضد:نفى عن نفسه صفات النوم والسِّنة. هَذِهِ الْآيَةُ تَتَضَمَّنُ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ خَمْسَةً، وَهِيَ: اللهُ، الْحَيُّ، الْقَيُّومُ، الْعَلِيُّ، الْعَظِيمُ. وما يشتق منهما من صفات فكل اسم لله تشتق منه صفة، وليس العكس. التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي تراب ; 19-09-23 الساعة 05:18 PM |
|
|

|
|
|
#5 |
|
نفع الله بك الأمة
|
من آية 256إلى آية 260. "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "256.لَمَّا اشتملتْ آيةُ الكُرسيِّ السَّابقة على دلائل الوَحدانيَّة، وعظمة الخالق، وتنزيهه عن شوائبِ ما كَفرتْ به الأمم، كان ذلك من شأنه أنْ يسوق ذوي العقول إلى قَبُول هذا الدِّين الواضِح العقيدة، المستقيم الشَّريعة، باختيارهم دون جَبْرٍ ولا إكراه، ومِن شأنه أن يَجعلَ دوامَهم على الشِّرك بمَحَلِّ السُّؤال: أيُتركَون عليه، أم يُكرَهون على الإسلام؟ فكانت الجملة استئنافًا بيانيًّا . معنى استئنافًا بيانيًّا :الاستئناف في عمومه ابتداءُ جملةٍ - في أثناء الكلامِ – منفصلةٍ إعرابًا عمَّا قبلها، فإن اتصلت معنًى بما قبلها بتقدير جوابٍ لسؤال مقدر كانت استئنافًا بيانيًّا، وإن انفصلت عمَّا قبلها معنًى وإعرابًا كانت استئنافًا نحويًّا.د. أحمد البحبح/أستاذ النحو والصرف المساعد بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة عدن. "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ:الإكراه معناه: حمل الغير على قول أو فعل لا يريده عن طريق التخويف أو التعذيب أو ما يشبه ذلك. والمراد بالدين دين الإسلام والألف واللام فيه للعهد. والرُّشْدُ: الهداية والاستقامة على طريق الحق.والمراد هنا: الحق والهدى.والْغَيِّ ضد الرُّشْدُ. أي: لا ينبغي أن تُرغِموا أحدًا على اعتناق الدِّين الإسلامي؛ إذ لا حاجةَ لذلك؛ فهو أمرٌ واضحٌ وجَلِيٌّ، قدْ تَميَّز من الضَّلال، وتبيَّنت أدلَّته، وظهرتْ حقائقه، فلا خفاءَ فيه ولا غموض، فمَن هداه الله تعالى له، وشرَح صدرَه، دخَل فيه على بيِّنة، ومَن أعمى الله قلبَه، فإنَّه لا يُفيده الدخولُ فيه مُكرَهًا عليه. والمقصودُ: أنَّ دِين الإسلام من حيث هو، واضحةٌ فيه معالمُ الحقِّ، ويتمايَز بجلاء عمَّا سواه من الباطل، ممَّا يُوجِب اعتناقَه مِن قِبَل كلِّ مُنصِفٍ مُرادُه اقتفاءُ الحقِّ. فالجملة الأولى وهي قوله-تبارك وتعالى" لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ" تنفي الإجبار على الدخول في الدين، لأن هذا الإجبار لا فائدة من ورائه، إذ التدين إذعان قلبي، واتجاه بالنفس والجوارح إلى الله رب العالمين بإرادة حُرة مختارة فإذا أُكره عليه الإنسان إزداد كرهًا له ونفورًا منه. فالإكراه والتدين نقيضان لا يجتمعان، ولا يمكن أن يكون أحدهما ثمرة للآخر. والجهاد ما شرع في الإسلام لإجبار الناس على الدخول في الإسلام إذ لا إسلام مع إجبار، وإنما شُرع الجهاد لدفع الظلم ورد العدوان وإعلاء كلمة الله، والرسول صلّى الله عليه وسلّم ما قاتل العرب ليكرههم على الدخول في الإسلام وإنما قاتلهم لأنهم بدءوه بالعداوة. والجملة الثانية وهي قوله-تبارك وتعالى" قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ" بمثابة العلة لنفي هذا الإكراه على الدخول في الدين، أي قد ظهر الصبح لذي عينين، وانكشف الحق من الباطل، والهدى من الضلال وقامت الأدلة الساطعة على أن دين الإسلام هو الدين الحق وغيره من الأديان ضلال وكفران ومادام الأمر كذلك فقد توافرت الأسباب التي تدعو إلى الدخول في دين الإسلام، ومن كفر به بعد ذلك فليحتمل نتيجة كفره، وسوء عاقبة أمره. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ: الطَّاغوت: هو كلُّ ما تَجاوَز به العبدُ حدَّه، من معبود، أو متبوع، أو مُطاع. إنَّ مَن جحَد ربوبيَّة الطَّاغوت وأُلوهيَّته المزعومتين، فتبرَّأ منه ومن عبادته وطاعته وآمَن بالله تعالى وحده وجودًا ورُبوبيَّةً وأُلوهيَّةً، وبما له من أسماء حسنى، وصفات عُلا، فعبَده وقَبِل خبرَه، وأذْعن لطلبه واتَّقاه، ممتَثِلًا أمره ومجتنبًا نهيه، فإنَّه قد تَمسَّك تمسُّكًا شديدًا بأقوى رِباط، وأَحْكمِ أمر، وهو دِينُ الله تعالى الحقُّ المبرَم، وهو أَوثَق ما يُتمسَّك به لطلب العِصمة والنَّجاة، فيبقى ثابتًا على الحقِّ، مستقيمًا عليه، دون أن يَخشى انقطاعًا وانفكاكًا بخِذلان الله تعالى له وإسلامه إلى التَّهلُكة. بِالْعُرْوَةِ : والعروة: في أصل معناها تطلق على ما يتعلق بالشيء من عراه أي من الجهة التي يجب تعليقه منها، وتجمع على عرى. والعروة من الدلو والكوز مقبضه، ومن الثوب مدخل زره. استعارة تمثيلية حيث شبه المستمسك بدين الإِسلام بالمستمسك بالحبل المحكم. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ :لَمَّا كان الكُفْر بالطَّاغوت، والإيمانُ بالله تعالى مُتعلِّقًا بالنُّطق باللِّسان، واعتقاد القلب،ناسب ذلك هذان الاسمان لله تعالى. قال تعالى"وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"أي: إنَّ الله تعالى يسمعُ كلَّ شيء، ومنه سَماعُه إعلان من أعلن الكفرَ بالطاغوتِ، والإيمانَ باللهِ، وإعلان من أعلن خلافَ ذلك،ويعلمُ أيضًا كلَّ شيء سبحانه، ومن ذلك علمه بما في صدور خلقه مِن الإيمانِ والكفرِ؛ فيُجازي كلَّ واحدٍ منهم بحسب ما يَنطِق به لسانه، وما تُضمِره نَفْسه؛ إنْ خيرًا فخير، وإنْ شرًّا فشر .موسوعة التفسير بالدرر السنية. "اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ"257. مُناسبة الآية لِمَا قبلها: أنَّ قولَهُ تعالى: اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا...... الآية وقع موقِعَ التعليلِ لقوله: لَا انْفِصَامَ لَهَا؛ لأنَّ الذين كفروا بالطَّاغوت وآمَنوا بالله، قد تَولَّوُا اللهَ فصار وَلِيَّهم؛ فبذلك يَستمرُّ تَمسُّكهم بالعُروة الوُثقى، ويأمَنون انفصامَها، وبعكسهم الذين اختاروا الكُفْرَ على الإسلام، فإنَّ اختيارَهم ذلك دلَّ على خَتْمٍ ضُرِبَ على قلوبهم، فلم يهتدوا، فهم يَزدادون في الضَّلال يومًا فيومًا. اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ: أي: مَن آمَن بالله حقًّا، فإنَّه جلَّ وعلا يتولَّاه على الدوام، فيكون عونًا له ونصيرًا، ويؤيِّده ويوفِّقه، ويمكِّنه من التوغُّل شيئًا فشيئًا في طريق اليقين الأوحد، فيَخرُج من ظلمات الضَّلال، ويَخترِق حُجُبَ الشُّبهات والشَّهوات المظلِمة، فيَنكشِف له نورُ الإيمان واليقين، ويُؤتَى نَفاذَ البصيرةِ، ويتجدَّد له السموُّ في مقامات الإيمان، والصُّعود في درجات اليقين، فيُبصِر قلبُه حقائقَ الأمور أكثرَ فأكثر. قال تعالى" وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ "محمد: 17. مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ: أفرد النور وجمع الظلمات لأن الحق واحد لا يتعدد وأما طرق الضلال فكثيرة ومتشعبة.صفوة التفاسير. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت فتولوا الشيطان وحزبه، واتخذوه من دون الله وليا ووالوه وتركوا ولاية ربهم وسيدهم، فسلطهم عليهم عقوبة لهم فكانوا يؤزونهم إلى المعاصي أزا، ويزعجونهم إلى الشر إزعاجا، فيخرجونهم من نور الإيمان والعلم والطاعة إلى ظلمة الكفر والجهل والمعاصي، فكان جزاؤهم على ذلك أن حرموا الخيرات، وفاتهم النعيم والبهجة والمسرات، وكانوا من حزب الشيطان وأولياءه في دار الحسرة، فلهذا قال تعالى أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ:وفي التعبير "بأصحاب النار" إشعار بأنهم ملازمون لها كما يلازم المالك ما يملكه والرفيق رفيقه. وقولههُمْ فِيها خالِدُونَ تأكيد لبقائهم فيها واختصاصهم بها. وبذلك تكون الآية الكريمة قد ساقت أحسن البشارات للمؤمنين، وأشد العقوبات للكافرين الذين استحبوا العمى على الهدى. ثم ساق القرآن بعد ذلك بعض الأمثلة للمؤمنين المهتدين وللضالين المغرورين.فقال-تبارك وتعالى: " أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ"258. حَاجَّ أى جادل وخاصم وتستعمل المحاجة كثيرا في المخاصمة بالباطل. - أي: إلى جرائته وتجاهله وعناده ومحاجته فيما لا يقبل التشكيك، وما حمله على ذلك إلا أن آتاه الله الملك فطغى وبغى ورأى نفسه مترئسا على رعيته، فحمله ذلك على أن حاج إبراهيم في ربوبية الله فزعم أنه يفعل كما يفعل الله،والاستفهام للتعجب من شأن هذا الكافر وما صار إليه أمر غروره وبطره والمراد به- كما قال ابن كثير- نمرود بن كنعان بن كوس بن سام ابن نوح ملك بابل، وكان معاصرًا لسيدنا إبراهيم- عليه السلام- إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ: وقوله: إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ حكاية لما قاله إبراهيم عليه السلام لذلك الملك في مقام التدليل على وحدانية الله وأنه- سبحانه - هو المستحق للعبادة أي قال له: ربي وحده هو الذي ينشئ الحياة ويوجدها، ويميت الأرواح ويفقدها حياتها، ولا يوجد أحد سواه يستطيع أن يفعل ذلك. أي: هو المنفرد بأنواع التصرف، وخص منه الإحياء والإماتة لكونهما أعظم أنواع التدابير، ولأن الإحياء مبدأ الحياة الدنيا والإماتة مبدأ ما يكون في الآخرة. ثم حكى القرآن جواب نمرود على إبراهيم فقال: قالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ أي قال ذلك الطاغية: إذا كنت يا إبراهيم تدعي أن ربك وحده الذي يحيي ويميت فأنا أعارضك في ذلك لأني أنا- أيضا أحيي وأميت وما دام الأمر كذلك فأنا مستحق للربوبية. قالوا: ويقصد بقوله أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُهذا أنه يستطيع أن يعفو عمن حكم بقتله، ويقتل من شاء أن يقتله. ولقد كان في استطاعة إبراهيم- عليه السلام- أن يبطل قوله، بأن يبين له بأن ما يدعيه ليس من الأحياء والإماتة المقصودين بالاحتجاج، لأن ما قصده إبراهيم هو إنشاء الحياة وإنشاء الموت، كان في استطاعة الخليل- عليه السلام- أن يفعل ذلك، ولكنه آثر ترك فتح باب الجدال والمحاورة، وأتاه بحجة هي غاية في الإفحام فقال له- كما حكى القرآن: فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ. أى قال إبراهيم لخصمه المغرور: لقد زعمت أنك تملك الإحياء والإماتة كما يملك الله-تبارك وتعالى- ذلك، ومن شأن هذا الزعم أن يجعلك مشاركا لله-تبارك وتعالى- في قدرته فإن كان ذلك صحيحا فأنت ترى وغيرك يرى أن الله-تبارك وتعالى- يأتي بالشمس من جهة المشرق عند شروقها فأئت بها أنت من جهة المغرب في هذا الوقت فماذا كانت نتيجة هذه الحجة الدامغة التي قذفها إبراهيم- عليه السلام- في وجه خصمه؟ كانت نتيجتها- كما حكى القرآن-فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ أي: غلب وقهر، وتحير وانقطع عن حجاجه، واضطرب ولم يستطع أن يتكلم، لأنه فوجئ بما لا يملك دفعه.وعبر عن هذا المبهوت بقوله: الَّذِي كَفَرَللإشعار بأن سبب حيرته واضطرابه هو كفره وعناده. ثم ختم- سبحانه - الآية بقوله: وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَأي لا يهديهم إلى طريق الحق.ولا يلهمهم حجة ولا برهانا.بسبب ظلمهم وطغيانهم وإيثارهم طريق الشيطان على طريق الرحمن. أي: إنَّ الله تعالى لا يُوفِّق أهلَ الباطلِ الذين ظلموا أنفسَهم بإيثارهم الكُفْرَ على الإيمان، بل يُبقِيهم على كُفْرهم وضَلالهم، ولو كان قَصْدهم الهدايةَ إلى الحقِّ، لوفَّقهم ويسَّر لهم الوصولَ إليه، فحُجَجهم باطِلة، لا يُمكِن أنْ يُبطِلوا بها حُججَ أهلِ الحقِّ عند المحاجَّة والمُناظَرة وبذلك نرى أن الآية الكريمة قد حكت للناس لونا من ألوان رعاية الله لأوليائه وخذلانه لأعدائه لكي يكون في ذلك عبرة وعظة لقوم يعقلون. ثم ساقت السورة الكريمة قصتين تدلان أبلغ دلالة على قدرة الله-تبارك وتعالى- وعلى صحة البعث والنشور . " أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" 259. هذا أيضا دليل آخر على توحد الله بالخلق والتدبير والإماتة والإحياء، أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا: قال الآلوسي ما ملخصه: قوله:أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ معطوف على سابقه- وهو قوله: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ والكاف اسمية بمعنى مثل . أي أو أرأيت مثل الذي مر على قرية.. وحذف لدلالة أَلَمْ تَرَ عليه. والذي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ قيل هو عزيز بن شرخيا، وقيل حزقيال بن بوزى وقيل غير ذلك، والقرية قيل المراد بها بيت المقدس وكان قد خربها «بختنصر» البابلي.. والقرآن الكريم لم يهتم بتحديد الأشخاص والأماكن لأنه يقصد العبرة وبيان الحال والشأن. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا:ومعنى وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها أن جدرانها ساقطة على سقوفها، أى أن الخراب قد عمها والدمار قد نزل بها، فأصبحت خالية من أهلها وفارغة ممن كان يعمرها وأصل الخواء الخلو.يقال خوت الدار وخربت تخوى خواء إذا سقطت وخلت. والعروش جمع عرش وهو سقف البيت ويسمى العريش، وكل شيء يهيأ ليظل أو يكنّ فهو عريش وعرش. والمعنى: أو أرأيت مثل الذي مر على قرية وهي ساقطة حيطانها على سقوفها، وفارغة ممن كان يسكنها، فهاله أمرها، وراعه شأنها، وقال على سبيل التعجب كيف يحيى الله هذه القرية بعد موتها، بأن يعيد إليها العمران بعد الخراب، ويجعلها عامرة بسكانها الذين خلت منهم. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ: ألبثه الله-تبارك وتعالى- في الموت مائة عام ثُمَّ بَعَثَهُأي أحياه ببعث روحه إلى بدنه قالَ كَمْ لَبِثْتَأي كم مدة من الزمان لبثتها على هذه الحال؟ قالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ.قال هذا استقصارا لتلك المدة التي مات فيها لكونه قد زالت معرفته وحواسه وكان عهد حاله قبل موته. قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ :أي: ليس الأمر كما قلت إنك لبثت يومًا أو بعض يوم بل إنك لبثت مائة عام ثم أرشده- سبحانه - إلى التأمل في أمور فيها أبلغ دلالة على قدرة الله تعالى وعلى صحة البعث فقال- سبحانه : فَانْظُرْ إِلى طَعامِكَ وَشَرابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ: قوله: لَمْ يَتَسَنَّهْ أي لم يتغير بمرور السنين الطويلة ولم تذهب طراوته فكأنه لم تمر عليه السنون . ففيه أكبر دليل على قدرته حيث أبقاه وحفظه عن التغير والفساد، مع أن الطعام والشراب من أسرع الأشياء فسادا. وَانْظُرْ إِلى حِمارِكَ :وكان قد مات وتمزق لحمه وجلده وانتثرت عظامه، وتفرقت أوصاله لموته ومرور مائة عام عليه. وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ : أي بموتك ثم بعثك بعد مائة عام هذا آية للناس على قدرة الله وبعثه الأموات من قبورهم، لتكون أنموذجا محسوسًا مُشاهدًا بالأبصار، فيعلموا بذلك صحة ما أَخبرتْ به الرسلُ. وَانْظُرْ إِلَى الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَكْسُوها لَحْمًا: وقوله: نُنْشِزُها : أي: نرفعها من الأرض ونردها إلى مكانها من الجسد ونركب بعضها على بعض وإنشاز الشيء رفعه وإزعاجه. والمعنى: قال الله-تبارك وتعالى- لهذا الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها إنك لم تلبث يوما أو بعض يوم في الموت كما تظن بل لبثت مائة عام فإن كنت في شك من ذلك ، سنريك آياتنا في نفسك وطعامك وشرابك، ولنجعلك آية للناس. فانظر إلى طعامك وشرابك لتشاهد أمرا آخر من دلائل قدرتنا فإن هذا الطعام والشراب كما ترى لم يتغير بمرور السنين وكر الأعوام بل بقي على حالته. وانظر إلى حمارك كيف نخرت عظامه، وتفرقت أوصاله مما يشهد بأنه قد مرت عليه السنوات الطويلة. ثم أحياه الله بأن ركب كل عظم في موضعه حتى صار حمارًا قائما من عظام لا لحم عليها ثم كساها الله لحمًا وعصبًا وعروقا وجلدًا بإذن الله عز وجل وذلك كله بمرأى من العزير. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ : فلما تبين له كيفية الإحياء أو فلما تبين له ما أشكل عليه من أمر إحياء الموتى قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. تلك هي القصة الأولى التي ساقها الله- تعالى كدليل على قدرته وعلى صحة البعث والنشور. أما القصة الثانية التي تؤكد هذا المعنى فقد حكاها القرآن في قوله: "وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" 260. قول إبراهيم عليه السلام رَبِّ تصريح بكمال أدبه مع خالقه ويعترف له بالربوبية الحقة، والألوهية التامة، ويلتمس منه معرفة كيفية إحياء الموتى، فهو لا يشك في قدرة الله ولا في صحة البعث- وحاشاه أن يفعل ذلك- فهو رسول من أولى العزم من الرسل، وقد تيقن ذلك بخبر الله تعالى، ولكنه أحب أن يشاهده عيانًا ليحصل له مرتبة عين اليقين . فهو يريد أن ينتقل من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين، ومن مرتبة البرهان إلى مرتبة العيان، فإن العيان يغرس في القلب أسمى وأقوى ألوان المعرفة والاطمئنان. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي : أي: فقال الله تعالى لخليله عليه السَّلام: أَوَلستَ قد آمنتَ؟ يعني: أنَّه ما دُمتَ قد آمَنتَ فلِمَ تَطلُبُ هذه الرؤيةَ؟ فأجاب نبيُّ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ بأنَّه مؤمن، لا يَعْتري إيمانَه أدنى شكٍّ، ولكنَّه لفَرْط محبَّته للوصولِ إلى مرتبةِ المُعايَنة، رامَ الترقِّي من درجة عِلْم اليقين إلى عَين اليقين، حتى يزدادَ إيمانًا، ويزدادَ قلبُه طُمأنينةً. قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا :أي: أجاب اللهُ تعالى طلبَه، فأَمَر إبراهيمَ عليه السَّلام أنْ يأخذ أربعةَ طيور، وأنْ يَذبَحهنَّ ويُقطِّعهنَّ؛ ليكون ذلك بمرأًى منه، ولِيَتِمَّ الأمرُ على يديه .ثم أَمَره اللهُ تعالى بتفريق أعضاء الطُّيور الأربعة التي قطَّعهنَّ، وقام بتَنْحِيتهنَّ عنه، بتَبدِيدهنَّ أجزاءً على رؤوس عدَّة جبالٍ؛ لتكون ظاهرةً للعِيان، وأَمَره أنْ يدعوهنَّ، ليُقبِلنَ عليه مُسرِعات، ففعل إبراهيمُ عليه السَّلام ذلك، وجئنَ طائراتٍ على أكمل ما يكون من الحياة. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ: أي: اعْلَم يا إبراهيمُ، أنَّ الذي فعَل ذلك له كمالُ العِزَّة، فلا يَغلِبه شيءٌ، ولا يَستعصي عليه شيٌء أراده، وأنَّ أفعاله وأقواله وأقداره وشرائعه كلَّها صادرةٌ عن كمال حِكْمته؛ فيَضَع كلَّ شيء في مُوضِعه الصَّحيح، ولا يَفعل- أبدًا- شيئًا عبثًا. موسوعة التفسير.الدرر السنية. |
|
|

|
|
|
#6 |
|
نفع الله بك الأمة
|
من آية 261 إلى آية 271 "مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ"261. بعد أن بيَّنَ سبحانه أمر البعث وقرره بالأدلة التي أراها للذي مر على قرية، ولإبراهيم صلوات الله عليه، ذكرهم بما ينفعهم بعد البعث فلن ينفعهم سوى أعمالهم الصالحة التي أهمها الإنفاق في سبيل الله ، فذكر هنا فضل الإنفاق وأن الحسنة قد يضاعفها الله إلى سبعمائة، ثم ضرب مثل السنبلة لذلك. قال أبو جعفر: وهذه الآية مردودة إلى قوله" مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ " البقرة: 245. هذا بيان للمضاعفة التي ذكرها الله في قوله مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً "البقرة:245.وهنا قال"مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"أي: مثل صدقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أي في طاعته ومرضاته، وأولاها إنفاقها في الجهاد في سبيله " كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ " أي مثل الذين ينفقون المال يبتغون به رضا الله وحسن مثوبته كمن يزرع حبة في أرض مغلة فتنبت سبع سنابل: أي تخرج ساقا تتشعب منه سبع شعب في كل سنبلة منها مائة حبة كما يرى في كثير من الحب كالذرة والدّخن. خلاصة ذلك - إن المنفق في إرضاء ربه وإعلاء دينه كمثل أبرك بذر زرع في أخصب أرض، فنما نموّا حسنًا فجاءت غلته سبعمائة ضعف.وهذا إحضار لصورة المضاعفة بهذا المثل، الذي كان العبد يشاهده ببصره فيشاهد هذه المضاعفة ببصيرته، فيقوى شاهد الإيمان مع شاهد العيان، فتنقاد النفس مذعنة للإنفاق سامحة بها مؤملة لهذه المضاعفة الجزيلة والمنة الجليلة، " وَاللَّهُ يُضَاعِفُ " هذه المضاعفة " لِمَن يَشَاءُ "بحسب حال المنفق وإخلاصه وصدقه وبحسب حال النفقة وحلها ونفعها ووقوعها موقعها، الفضل،وفي هذا التشبيه ما فيه من الحض على الإنفاق في وجوه الخير، ومن الترغيب في فعل البر ولا سيما النفقة في الجهاد في سبيل الله. قال ابن كثير: وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد السبعمائة. فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله-تبارك وتعالى-لأصحابها كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة". إذ عطاء الله لمن يشاء من عباده ليس له حدود، وثوابه ليس له حسابمعدود. ولذا ختم- سبحانه - الآية بقوله: وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ أي والله-تبارك وتعالى- عطاؤه واسع، وجُوده عميم، وفضله كبير، وهو-تبارك وتعالى- عليم بنيات عباده وبأقوالهم وبأفعالهم وبسائر شئونهم، فيجازي كل إنسان على حسب نيته وعمله. "الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ"262. لمَّا عَظَّم أمرَ الإنفاق في سبيل الله، ورتَّب عليه الثواب المضاعف، أَتْبعه ببيان الأمور التي يجب تحصيلُها حتى يبقَى ذلك الثوابُ، ومنها تَرْكُ المنِّ والأذى . ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى :تحذير للمتصدق من هاتين الصفتين الذميمتين لأنهما مبطلتان لثواب الصدقة. والمنّ معناه: أن يتطاول المحسن بإحسانه على من أحسن إليه، ويتفاخر عليه بسبب ما أعطاه من عطايا. كأن يقول على سبيل التفاخر والتعبير: لقد أحسنت إليك وأنقذتك من الفقر وما يشبه ذلك. فذلك محظورٌ لِمَا فيه من تَكبُّر المُنفِق واستعلائه، واستعباد المُنفَق عليه، وكسْر قلبِه وإذلاله، بل على المُعطي في سبيل الله تعالى أنْ يشهد دائمًا أنَّ المتفضِّل والمُنعِم حقيقةً هو الله تعالى وحده، وعليه أنْ يتفكَّر أيضًا في أنَّ أجْره على الله تعالى بأضعافِ ما أَعطى، فأيُّ حقٍّ بقي له على الآخذ المُحتاج حتى يَمتنَّ عليه، أو يؤذيه بصنائع معروفه.قال الإمام الرازي ما ملخصه: والمن في اللغة على وجوه: فقد يأتي بمعنى الإنعام. يقال:قد من الله على فلان.إذا أنعم عليه بنعمه. وقد يأتي بمعنى النقص من الحق والبخس له. أي: إنَّ هؤلاء الذين يُنفِقون أموالَهم في سبيل الله تعالى بلا منٍّ ولا أذًى، يَستحِقُّون- وحْدَهم دون غيرهم من المنفقين- ثوابًا وجزاءً من الله تعالى وحده، قد تَكفَّل به الكريم مُقابِلَ صنيعهم هذا، فهو مُوفِّيه إيَّاهم لا محالة، ولهم مع ذلك أيضًا ألَّا يَخافوا من المستقبل ومِن ذلك، عدَم خوفهم عند مَقدَمهم على الله تعالى حين فِراقِهم للدُّنيا، ولا في أهوال القيامة، فلا يَنالُهم فيها مكروهٌ، ولا يُصيبهم فيها عقابٌ، ولا يحزنون أيضًا على ما مضى، ومن ذلك ما يُخلِّفونه وراءهم في الدنيا من أموالٍ وبنينَ عَقِب موتهم؛ لأنَّهم قد صاروا إلى ما هو خيرٌ لهم من ذلك، فحصَلتْ لهم بذلك الخيراتُ، واندفعت عنهم الشرورُ والسيئات. "قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ".263 قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ:أي كلام حسن ورَد على السائل جميل بأن تقول للسائل كلامًا جميلًا طيبًا يجبُر به خاطرَهُ، ويحفظ له كرامتَهُ. وَمَغْفِرَةٌ : يعني: وسترٌ من المنفق على الفقير لمِا عَلِمَ من سوء حالته . ويدخل فيه العفو عما يصدر من السائل مما لا ينبغي. أي كلامٌ حسنٌ وردّ جميلٌ على السائلِ، وسترٌ لمِا وقع منه من الإلحاف في السؤال وغيره أنفع لكم وأكثر فائدة من صدقة فيها الأذى، لأنه وإن خيّب رجاءه - بعدم إعطائة الصدقة - فقد أفرح قلبه وهوّن عليه ذل السؤال بالقول المعروف اللين ، وهذا القول تارة يتوجه إلى السائل إن كانت الصدقة عليه، وتارة أخرى يتوجه إلى المصلحة العامة، كما إذا احتيج لجمع المال لدفع عدوّ مهاجم أو بناء مستشفى أو مدرسة أو نحو ذلك من أعمال الخير والبر ولم يكن لدى المرء مال، فعليه أن يساعد بالقول المعروف الذي يحث العاملين على العمل، وينشطهم إليه، ويبعث عزيمة الباذلين على الزيادة في البذل، أما الصدقة التي يتبعها أذى فهي مشوبة بضرر ما يتبعها من الإيذاء، ومن آذى فقد بغّض نفسه إلى الناس بظهوره في مظهر البغض لهم، والسلم والولاء خير من العداوة والبغضاء. وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ: أي والله غني عن صدقة عباده، فلا يأمرهم ببذل المال لحاجة إليه، بل ليطهرهم ويزكيهم ويؤلف بين قلوبهم ويصلح شئونهم الاجتماعية، ليكونوا أعزاء، بعضهم لبعض ناصر ومعين. فهو غني عن صدقة يتبعها منّ أو أذى، لأنه لا يقبل إلا الطيبات، حليم لا يعجل بعقوبة من يمنّ أو يؤذي. وفي هذه الجملة سلوة للفقراء، وتعليق لقلوبهم بحبل الرجاء بالله الغني الحليم، وتهديد للأغنياء وإنذار لهم بألا يغتروا بحلم الله وإمهاله إياهم، وعدم تعجيل العقوبة على كفرهم بنعمته تعالى، إذ من وهبهم المال فإنه يوشك أن يسلبه منهم. "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ"264. نداء منه- سبحانه - للمؤمنين يكرر فيه نهيهم عن المن والأذى، لأنهما يؤديان إلى ذهاب الأجر - وحبوط العمل . ثم أكد- سبحانه - هذا النهي عن المن والأذى بذكر مثالين فقال في أولهما: كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.والمعنى: يا من آمنتم بالله-تبارك وتعالى- لا تبطلوا صدقاتكم بأن تحبطوا أجرها، وتمحقوا ثمارها، بسبب المن والأذى، فيكون مثلكم في هذا الإبطال لصدقاتكم ، كمثل المنافق الذي ينفق ماله من أجل أن يرى الناسُ منه ذلك ولا يبغي به وجه الله ولا ثواب الآخرة، لأنه كفر بالله، وكفر بحساب الآخرة. وأما المثال الثاني فقال- سبحانه: فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرابٌ فَأَصابَهُ وابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا. الصفوان اسم جنس جمعي واحده صفوانة كشجر وشجرة وهو الحجر الكبير الأملس، مأخوذ من الصفاء وهو خلوص الشيء مما يشوبه. يقال: يوم صفوان أي صافي الشمس. والوابل المطر الشديد.والصلد هو الشيء الأجرد النقي من التراب الذي كان عليه. أي: إنَّ قلب هذا المنافق الذي يُنفق مالَه رياءً، غيرَ مؤمن بالله ولا باليوم الآخِر، حالُه في صلابته وشِدَّته، وعدم الانتفاع به- لعدم إيمانه وإخلاصِه لله تعالى- تُشبِهُ حالَ حجر أملس، ونفقة هذا المنافق تُشبه ترابًا يعلو هذا الحجرَ، فهو مستندٌ إليه، يَظنُّ مَن يراه أنه أرضٌ طيِّبة صالحة للإنبات، مثلما يظنُّ مَن يشاهد ظاهرَ حال المنافق أنَّ صدقته مبنيَّة على أساس من الإيمان والإخلاص لله عزَّ وجلَّ، فتُثمر له حسناتٍ، وشبَّه الله تعالى تعرُّض التراب لمطرٍ غزيرٍ شديد الوقع، بالمانع الذي أبطل صدقتَه، وذهب بأثرها تمامًا. وكما أصبح الحجر في نهاية الأمر، صلبًا كما عُهِد من قبلُ، وخاليًا لا شيءَ عليه من ترابٍ، ولم يبقَ أملٌ في إنبات نبات، فكذلك صدقات هذا المنافِق تَذهب هباءً، لا تُثمر شيئًا من الحسنات وزيادة الإيمان؛ لأنَّه لا أصل لها تُؤسَّس عليه، ولا لها مقصدٌ طيِّب تنتهي إليه، فكل ما قدَّمه مضمحل. فإذا كان يومُ القيامة، وجاء وقتُ حصاد الزَّرع وتلقِّي أجور العاملين، وظنُّوا أنهم سيَنتفعون بما قدَّموه، لم يجدوا شيئًا يحصدُونه، ولا أجرًا يتلقَّوْنه، فقد اضمحلَّ ما قدَّموه كلُّه؛ لأنَّه لم يكُن لله تعالى، فلا تكونوا- أيُّها المؤمنون- كهؤلاء المنافقين، فتُبطلوا أجورَ صدقاتكم بمنِّكم وأذاكم على مَن تصدَّقتم عليه. لا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا : لا يقدرون يوم القيامة على ثواب شيء مما كسبوا في الدنيا، لأنهم لم يعملوا لمعادهم، ولا لطلب ما عند الله في الآخرة، ولكنهم عملوه رئاء الناس وطلبَ حمدهم.وإنما حظهم من أعمالهم، ما أرادوه وطلبوه بها. وإنما حظهم من أعمالهم، ما أرادوه وطلبوه بها. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ:أي لا يسدّدهم لإصابة الحق في نفقاتهم وغيرها، فيوفقهم لها، وهم للباطل عليها مؤثرون، ولكنه يتركهم في ضلالتهم يعمهون يترددون ويتقلبون في ضلالهم ولا يخرجون منه . "وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ " 265. بعد أن بين القرآن سوء عاقبة الذين يراءون في صدقتهم، أتبع ذلك ببيان حسن عاقبة الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ : ابتغاء مرضاة الله في الإنفاق تعني خروج الرياء من دائرة الإنفاق، فيكون خالصًا لوجهه سبحانه .وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ:المُراد بالتَّثبيت تَوطين النَّفْس على المحافظة عليه وتَرْك ما يُفسِده، فالنفقة يعرض لها آفتان إما أن يقصد الإنسان بها ثناء الناس ومدحهم وهو الرياء، أو يخرجها على خور وضعف عزيمة وتردد، فهؤلاء سلموا من هاتين الآفتين فأنفقوا ابتغاء مرضات الله لا لغير ذلك من المقاصد، وتثبيتا من أنفسهم، واعتقادًا راسخًا ويقينًا مطمئنةً أنفسُهم بصدق وعد الله غيرَ كارهة أو مترددة . كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ : وهذا المثَل يتضمَّن التَّحريض على الإنفاق في سبيل الله. جَنَّةٍ: البستان جيد التربة ملتف الشجر، عظيمة الخصب، تنبت كثيرا من الغلات ،بِرَبْوَةٍ:والربوة المكان المرتفع من الأرض، وأشجار الربى أحسن منظرا وأزكى ثمرا للطافة هوائها وفعل الشمس فيها،أَصَابَهَا وَابِلٌ : أي نزل عليها مطر كثير . فَآتَتْ أُكُلَهَا :أكلها: أي أعطت صاحبها أكلها، والأكل كل ما يؤكل والمراد هنا الثمر، ضِعْفَيْنِ :وضعف الشيء مثله، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ :والطلّ المطر الخفيف، وإن لم يصبها الوابل فطلّ ومطر خفيف يكفيها لجودة تربتها وكرم منبتها وحسن موقعها، وهكذا كثير البر كثير الجود إن أصابه خير كثير أغدق ووسّع في الإنفاق، وإن أصابه خير قليل أنفق بقدره، فخيره دائم، وبره لا ينقطع . فمثل المؤمنين الذين يبذلون أموالهم طلبًا لرضوان الله، مطمئنةً أنفسُهم بصدق وعد الله غيرَ مكرهة، كمثل بستان على مكان مرتفع طيب، أصابه مطر غزير، فأنتج ثمرًا مضاعفًا، فإن لم يصبه مطر غزير أصابه مطر خفيف فاكتفى به لطيب أرضه، وكذلك نفقات المخلصين يقبلها الله ويضاعف أجرها وإن كانت قليلة،وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ:والله بما تعملون بصير، فلا يخفى عليه حال المخلصين والمرائين، وسيجازي كلًّا بما يستحق. " أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ"266. الآية الكريمة قد اشتملت على مثل آخر لحالة الذين يبطلون أعمالهم وصدقاتهم بالمن والأذى والرياء، وغير ذلك من الأفعال القبيحة والصفات السيئة. قوله: أَيَوَدُّ هو من الود بمعنى المحبة الكاملة للشيء وتمنى حصوله، والاستفهام فيه للإنكار. والمعنى: أيحب أحدكم- أيها المنانون المراءون- أن تكون له جنة معظم شجرها مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ تجرى من تحت أشجارها الْأَنْهارُ لَهُ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ النافعة، فهي جنة قد جمعت بين حسن المنظر، وكثرة النفع، وهذا نهاية ما يتمناه كل إنسان لما يملكه. والحال أنه قد أصابه الكبر الذي أقعده عن الكسب من غير تلك الحديقة اليانعة، وله فضلا عن شيخوخته وعجزه ذرية ضعفاء لا يقدرون على العمل، وبينما هو على هذه الحالة إذا بالجنة ينزل عليها إعصار فيه نار فيحرقها ويدمرها ففقدها صاحبها وهو أحوج ما يكون إليها وبقي هو وأولاده في حالة شديدة من البؤس والحيرة والغم والحسرة لحرمانه من تلك الحديقة التي كانت محط آماله. فقد شبه- سبحانه - حال من يعمل الأعمال الحسنة ثم يضم إليها ما يفسدها فإذا كان يوم القيامة واشتدت حاجته إليها وجدها محبطة ذاهبة، شبه هذا الإنسان في حسرته وألمه وحزنه بحال ذلك الشيخ الكبير العاجز الذي له ذرية ضعفاء لا يملك سوى حديقة يانعة قد جمعت بين حسن المنظر، وكثرة النفع، وهذا نهاية ما يتمناه كل إنسان لما يملكه.يعتمد عليها في معاشه هو وأولاده فنزل عليها إعصار فيه نار فأحرقها ودمرها تدميرا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ: أي: كما يبين الله في هذه الآية ما يهديكم وينفعكم يبين لكم آياته وهداياته في سائر أمور دينكم لكي تتفكروا فيما يصلحكم، وتعملوا ما يرضي خالقكم. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ :أي: تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني ، وتنزلونها على المراد منها. "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ "267. بعد أن حضهم على الإنفاق بسخاء وإخلاص؛ وجه نداء إلى المؤمنين أمرهم فيه بأن يتحروا في نفقتهم الحلال الطيب. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ :الطيب: هو الجيد المستطاب، وضده الخبيث المُستكره.يَحُثُّ الله تعالى عبادَه المؤمنين على أن يُزكُّوا ويتصدَّقوا من أجود أموالهم التي اكتسبوها حلالًا بالتِّجارة، وأمرهم أن يُنفِقوا من الثِّمار والزروع والرِّكاز والمعادن التي أخرجها لهم سبحانه من الأرض، فكما منَّ عليهم بتيسير الحصول على ذلك، فلْيُنفِقوا منه شكرًا له عزَّ وجلَّ. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ : ولا تيمموا أي لا تقصدوا الخبيث الرديء من أموالكم فتخصّوه بالإنفاق منه. وتغمضوا أي تتساهلوا وتتسامحوا من قولهم أغمض فلان عن بعض حقه إذا غض بصره، ويقال للبائع أغمض أي لا تستقص كأنك لا تبصر. جُعِلَ كل تجاوز ومساهلة في البيع وغيره إغماضا. من شأن المؤمن الصادق في إيمانه ألا يفعل لغيره إلا ما يجب أن يفعله لنفسه، ولا يعطى من شيء إلا ما يحب أن يعطى إليه. قال صلى الله عليه وسلم "يا أبا هريرةَ كن ورعًا تكن أعبدَ الناسِ وكن قنعًا تكن أشكرَ الناسِ وأحبَّ للناسِ ما تحبُّ لنفسِك تكن مؤمنًا وأحسِنْ جوارَ من جاورَك تكن مسلمًا وأقِلَّ الضحكَ فإنَّ كثرةَ الضحكِ تميتُ القلبَ"الراوي : أبو هريرة - المحدث : الألباني -المصدر : صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم : 3417 - خلاصة حكم المحدث : صحيح. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ : أي واعلموا أن الله-تبارك وتعالى- غني عن صدقاتكم وإنما أمركم بها لمنفعتكم،حَمِيدٌيجازي المحسن أفضل الجزاء، وهو- سبحانه - المستحق للحمد الحقيقي دون سواه، فمن الواجب عليكم أن تبذلوا في سبيله الجيد من أموالكم شكرا له على نعمه حتى يزيدكم من عطائه وآلائه. . وحميد أي مستحق للحمد على نعمه العظام... ولا تقصدوا الخبيث الرديء من أموالكم فتخصّوه بالإنفاق منه. "الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ "268. وتشمل الفحشاء أيضًا ما سوى البُخل، من قبائح المعاصي والمنكرات. البخل واختيار الرديء للصدقة من الشيطان الذي يخوفكم الفقر، ويغريكم بالبخل،والفحشاء : تطلق في لغة العرب على البخيل الشديد البخل. وتشمل الفحشاء أيضًا ما سوى البُخل، من قبائح المعاصي والمنكرات. قال الجمل: وفي هذه الآية لطيفة وهي أن الشيطان يخوف الرجل أولا بالفقر ثم يتوصل بهذا التخويف إلى أن يأمره بالفحشاء وهو البخل، وذلك لأن البخل صفة مذمومة عند كل أحد فلا يستطيع الشيطان أن يحسن له البخل إلا بتلك المقدمة وهي التخويف من الفقر. وسمي ذلك التخويف وعدًا مبالغة في الإخبار بتحقق وقوعه، وكأن مجيئه بحسب إرادته وطوع مشيئة الشيطان .هيهات هيهات. وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا : الله سبحانه وتعالى يعدكم على إنفاقكم غفرانًا لذنوبكم ورزقًا واسعًا. فالله-تبارك وتعالى- يعدكم مغفرة منه لذنوبكم على ما تنفقونه من أموالكم في سبيله ففي الحديث الشريف: قال صلى الله عليه وسلم"الصدقَةُ تُطْفِئُ الخطيئةَ كما يُطْفِئُ الماءُ النارَ"الراوي : معاذ بن جبل - المحدث : الألباني - المصدر : تخريج مشكلة الفقر- الصفحة أو الرقم : 117 - خلاصة حكم المحدث : صحيح. ويعدكم- أيضا- فَضْلًا أي نماء وزيادة في أموالكم، فإن الصدقات تزيد البركة في الرزق فيصير القليل منه في يد السخي كثيرا بتوفيق الله وتأييده. قال صلى الله عليه وسلم "ما مِن يَومٍ يُصْبِحُ العِبادُ فِيهِ، إلَّا مَلَكانِ يَنْزِلانِ، فيَقولُ أحَدُهُما: اللَّهُمَّ أعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، ويقولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا." الراوي : أبو هريرة - صحيح البخاري. قال صلى الله عليه وسلم "ما نَقَصَتْ صَدَقةٌ مِن مالٍ، وما زادَ اللَّهُ عَبْدًا بعَفْوٍ إلَّا عِزًّا، وما تَواضَعَ أحَدٌ للَّهِ إلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ."الراوي : أبو هريرة - صحيح مسلم. في هذا الحديثِ يُبَيِّنُ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الصَّدَقةَ لا تكونُ سَببًا في نَقصِ المالِ، بَلْ تَزيدُه أضعافَ ما يُعطَى منه بأنْ يَنجَبِرَ بِالبركةِ، والَّتي تَتعدَّدُ صُوَرُها في النَّفْسِ والأهلِ، وفي المالِ ذاتِه، وأنَّه وإنْ نَقَصَت صُورتُه كان في الثَّوابِ المرتَّبِ عليها جَبرًا لنَقصِه وزِيادةً إلى أضعافٍ كَثيرةٍ. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ: والله واسع الفضل، عليم بالأعمال والنيَّات ، واسع الصِّفات، ومن ذلك سَعَةُ عِلْمه؛ فهو عليمٌ بمن يَستحِقُّ فضْله منكم، وعليم بنفقاتكم التي تُنفِقون، فيُحصيها لكم ويُجازيكم بها من سَعَة فضله. "يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ "269. لما ذكر في الآية المتقدمة أن الشيطان يعد بالفقر ويأمر بالفحشاء، وأن الرحمن يعد بالمغفرة والفضل نبه على أن الأمر الذي أوجب لأجله ترجيح وعد الرحمن على وعد الشيطان هو أن وعد الرحمن ترجحه الحكمة والعقل ووعد الشيطان ترجحه الشهوة والنفس من حيث إنهما يأمران بتحصيل اللذة الحاضرة واتباع أحكام الخيال والوهم. لما أمر تعالى بهذه الأوامر العظيمة المشتملة على الأسرار والحكم وكان ذلك لا يحصل لكل أحد، بل لمن منَّ عليه وآتاه الله الحكمة، وهي العلم النافع والعمل الصالح ومعرفة أسرار الشرائع وحكمها، وإن من آتاه الله الحكمة فقد آتاه خيرا كثيرا وأي خير أعظم من خير فيه سعادة الدارين والنجاة من شقاوتهما! وفيه التخصيص بهذا الفضل وكونه من ورثة الأنبياء، فكمال العبد متوقف على الحكمة، إذ كماله بتكميل قوتيه العلمية والعملية فتكميل قوته العلمية بمعرفة الحق ومعرفة المقصود به، وتكميل قوته العملية بالعمل بالخير وترك الشر، وبذلك يتمكن من الإصابة بالقول والعمل وتنزيل الأمور منازلها في نفسه وفي غيره، وبدون ذلك لا يمكنه ذلك، ولما كان الله تعالى قد فطر عباده على عبادته ومحبة الخير والقصد للحق، فبعث الله الرسل مذكرين لهم بما ركز في فطرهم وعقولهم، ومفصلين لهم ما لم يعرفوه، انقسم الناس قسمين قسم أجابوا دعوتهم فتذكروا ما ينفعهم ففعلوه، وما يضرهم فتركوه، وهؤلاء هم أولو الألباب الكاملة، والعقول التامة، وقسم لم يستجيبوا لدعوتهم، بل أجابوا ما عرض لفطرهم من الفساد، وتركوا طاعة رب العباد، فهؤلاء ليسوا من أولي الألباب. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا : أي: إنَّ من يُعطَى تلك الحِكمة من العباد، فيخرج من ظُلْمة الجهل إلى نورِ الهُدى، ومن حُمْق السَّفه والانحراف في الأقوال والأفعال، إلى إصابة الصَّواب فيهما، وحصول التَّوفيق والسَّداد، فقد مُنح خيرًا عظيمًا لا يُقدَّر؛ فإنَّ الحكمة أفضلُ الأُعطيات، وهي أجلُّ المنح والهِبات. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ : والألباب جمع لُب وهو في الأصل خلاصة الشيء وقلبه، وأطلق هنا على عقل الإنسان لأنه أنفع شيء فيه. والمراد بأولي الألباب هنا أصحاب العقول السليمة التي تخلصت من شوائب الهوى، ودوافع الشر، فقد جرت عادة القرآن ألا يستعمل هذا التعبير إلا مع أصحاب العقول المستقيمة. أي: لا يتَّعظ بما وعظ به الله تعالى في آياتِه المُنفِقين أموالَهم وغيرَهم، فيَذكُر وعدَه ووعيدَه، فيَنزجِر عمَّا زجره عنه ربُّه، ويُطيعه فيما أمره به سبحانه، إلَّا أصحابُ العقول الكاملة، الذين يَعقِلون بها عن الله عزَّ وجلَّ أمرَه ونهيه. "وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ "270. النفقة: هي العطاء العاجل في باب من أبواب الخير. أما النذر: فهو التزام قربة من القربات أو صدقة من الصدقات بأن يقول: لله علي نذر أن أفعل كذا من أنواع البر. أو إن شفى الله مريضي فسأفعل كذا. والمعنى: وما أنفقتم- أيها المؤمنون- من نفقة عاجلة قليلة أو كثيرة، أو التزمتم بنفقة مستقبلة وعاهدتم الله-تبارك وتعالى- على القيام بها، فإنه- سبحانه - يعلم كل شيء، ويعلم ما صاحب نياتكم من إخلاص أو رياء، ويعلم ما أنفقتموه أهو من جيد أموالكم أم من رديئها، وسيجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فالآية الكريمة بيان لحكم كلي شامل لجميع أفراد النفقات إثر بيان حكم ما كان منها في سبيل الله-تبارك وتعالى. وقوله: فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ :كناية عن الجزاء عليه، لأن علم الله-تبارك وتعالى- بالكائنات لا يشك فيه السامعون، فأريد لازم معناه وهو الجزاء. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ:والمراد بالظالمين: الواضعون للأشياء في غير موضعها التي يجب أن توضع فيها، والتاركون لما أمرهم الله به، فيندرج فيهم الذين يبطلون صدقاتهم بالمن والأذى والرياء والذين يتصدقون بالرديء من أموالهم، والذين ينفقون أموالهم في الوجوه التي نهى الله عنها، والذين لم يوفوا بنذورهم التي عاهدوا الله على الوفاء بها كما يندرج فيهم كل من ارتكب ما نهى الله عنه أو أهمل فيما كلفه الله به. قوله: وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْأَنْصارٍ وعيد شديد للخارجين على طاعة الله أي: ليس للظالمين أي نصير أو مغيث يمنع عقوبة الله عنهم. "إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ "271. بين- سبحانه - أن الصدقة متى صدرت عن المسلّم بالطريقة التي دعت إليها تعاليم الإسلام فإنها تكون مرجوة القبول عند الله-تبارك وتعالى- سواء أفعلها المسلّم في السر أم في العلن.الصدقات: جمع صدقة وهي ما يخرجه المسلّم من ماله على جهة القربة، وتشمل الفرض والتطوع، وهي مأخوذة من الصدق بمعنى صدق النية وتخليصها من كل ما نهى الله عنه، وسمى- سبحانه - ما يخرجه المسلّم من ماله صدقة لأن المال بها يزكو وينمو يطهر. إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ :أي: إنْ تُظهِروا الصَّدقاتِ فتُعطوها علانيةً، فنِعْم الشيءُ هي؛ لحصول المقصود بها، ما دام أنَّها خالصة لله تعالى. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ :أي: إنْ تَستروا صدقتَكم غيرَ المفروضة عليكم، فتُعْطوها الفقراءَ في السرِّ، فإخفاؤكم إيَّاها أفضلُ لكم من إظهارها وإعلانها، ففي إخفائها: السَّترُ على الفقير، وحِفْظ ماء وجهه بعدم تَخجيله وفضيحته بين الناس، وهذا قدْرٌ زائدٌ عن الإحسان إليه بمجرَّد الصَّدقة، مع كونه أَدْعى إلى إخلاص صاحبها، وأَبْعدَ له عن الرِّياء. وقيَّد تعالى الإخفاءَ بإيتاء الفقراء خاصَّة؛ لأنَّ من الصَّدقة ما لا يُمكِن إخفاؤه كتجهيز الجيش، أو يتَرتَّب على الإظهار مصلحةٌ راجحةٌ، كإظهار شعائر الدِّين، وحصول اقتداء النَّاس به. عن أبي هُرَيرَة رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال "سبعةٌ يُظِلُّهُم اللهُ تعالى في ظِلِّه يومَ لا ظِلَّ إلا ظِلُّه: إمامٌ عَدْلٌ، وشابٌّ نشأَ في عبادةِ اللهِ، ورجلٌ قلبُه مُعَلَّقٌ في المساجدِ، ورجلانِ تَحابَّا في اللهِ؛ اجتَمَعا عليه، وتفرَّقا عليه، ورجلٌ دعَتْهُ امرأةٌ ذاتُ منصبٍ وجمالٍ، فقال: إنِّي أخافُ اللهَ،ورجلٌ تصدَّقَ بصدقة، فأخفاها حتى لا تعلمَ شمالُه ما تُنْفِقْ يمينُه، ورجلٌ ذَكَرَ اللهَ خاليًا ففاضتْ عَيناه"رواه البخاري :1423-واللفظ له، ومسلم :1031. وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ :لَمَّا امتدَح اللهُ تعالى الصدقةَ عَلَنًا كانت أو سرًّا، لا سيَّما إن كانت سرًّا؛ لأنَّها أفضل للمُتصدِّق، وتضمَّن ذلك حصولُ الثَّواب، بيَّن أنَّه يَسْتُر بها السيِّئاتِ جميعَها، أو بعضَها؛ دفعًا للعقاب. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ :أي: إنَّ الله عزَّ وجلَّ مُطَّلِعٌ على ما تعملون في صدقاتِكم، من إعلانٍ بها وإسرار، وعلى غير ذلك من أعمالكم، فيُحصيها لكم ويُجازي كلًّا بعمله، فهو سبحانه ذو علمٍ ببواطن الأمور وظواهِرها، لا يَخْفى عليه شيءٌ من أعمالكم ونيَّاتِكم.
|
|
|

|
|
|
#7 |
|
نفع الله بك الأمة
|
من آية 272 إلى آية281 "لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ "272. قال الكلبي سبب نزول هذه الآية أن ناسًا من المسلمين كانت لهم قرابة وأصهار في اليهود وكانوا ينفقون عليهم قبل أن يسلموا فلما أسلموا كرهوا أن ينفقوا عليهم وأرادوهم على أن يسلموا ؛ أي كي يَدخلوا في الإسلام حاجةً منهم للصدقة . فنزلت هذه الآية . أي: ليس عليك- يا محمَّد- هداية الخَلْق إلى الإسلام هدايةَ توفيقٍ، وإنَّما عليك البلاغ وهو هداية الإرشاد. إنما عليك البلاغ المبين، والهداية بيد الله تعالى.فمهما منعت الصدقة عنهم أنت ومن معك من المؤمنين لن يهتدوا إلا بإذن الله.عن ابنِ عبَّاسٍ قالوا: كانوا يكرَهونَ أنْ يرضَخوا لأنسابِهم وهم مشرِكونَ، فنزَلتْ"لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ..." حتى بلَغَ"وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ..."البقرة: 272. فرخَّصَ."الراوي : سعيد بن جبير - المحدث : الوادعي - المصدر : الصحيح المسند-الصفحة أو الرقم : 632 - خلاصة حكم المحدث : صحيح. رَاضَخَ فلانٌ شيئًا: أَعطاهُ كَارهًا. ففيها دلالة على أن النفقة كما تكون على المسلم تكون على الكافر ولو لم يهتد. فعليك وعلى أتباعك أن تعاملوا غيركم بما يوجبه عليكم إيمانكم من سماحة في الخلق، وعطف على المحتاجين حتى ولو كانوا من المخالفين لكم في الدين. على هذا المعنى الذي يؤيده سبب النزول يكون الضمير في قوله: هُداهُمْ يعود على غير المسلمين. هذه الصدقة التي أبيحت لهم حسب ما تضمنته هذه الآثار هي صدقة التطوع، وأما المفروضة فلا يجزئ دفعها لكافر، لقوله صلّى الله عليه وسلّم" أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عنْه إلى اليَمَنِ، فَقالَ: ادْعُهُمْ إلى شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأَنِّي رَسولُ اللَّهِ، فإنْ هُمْ أطَاعُوا لذلكَ، فأعْلِمْهُمْ أنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عليهم خَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلِّ يَومٍ ولَيْلَةٍ، فإنْ هُمْ أطَاعُوا لذلكَ، فأعْلِمْهُمْ أنَّ اللَّهَافْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً في أمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِن أغْنِيَائِهِمْ وتُرَدُّ علَى فُقَرَائِهِمْ."الراوي : عبدالله بن عباس –صحيح البخاري. في الحديثِ:أنَّ الحَدَّ الفارقَ ما بيْنَ الغنيِّ والفقيرِ هو امتلاكُ قَدْرِ المالِ الذي تجبُ فيه الزَّكاةُ. "لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ....." أي وما تنفقواقليل أو كثير على أي شخص كان من مسلم وكافر فلأنفسكم - أي: نفعه راجع إليكم يُخلِفَ اللهُ عليه في الدُّنيا أو الآخرةِ ، بالسعادة في الدنيا والبركة، وبالثواب الجزيل في الآخرة. قالصلّى الله عليه وسلّم "ما مِن يَومٍ يُصْبِحُ العِبادُ فِيهِ، إلَّا مَلَكانِ يَنْزِلانِ، فيَقولُ أحَدُهُما: اللَّهُمَّ أعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، ويقولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا".الراوي : أبو هريرة - صحيح البخاري. وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ : هذا إخبار عن نفقات المؤمنين الصادرة عن إيمانهم أنها لا تكون إلا لوجه الله تعالى، لأن إيمانهم يمنعهم عن المقاصد الردية ويوجب لهم الإخلاص.وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله ، ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب : ألبر أو فاجر أو مستحق أو غيره ، هو مثاب على قصده. عن أبي هريرة رضي الله عنه :أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: قالَ رَجُلٌ: لَأَتَصَدَّقَنَّ بصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا في يَدِ سَارِقٍ، فأصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ علَى سَارِقٍ فَقالَ: اللَّهُمَّ لكَ الحَمْدُ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا في يَدَيْ زَانِيَةٍ، فأصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ علَى زَانِيَةٍ، فَقالَ: اللَّهُمَّ لكَ الحَمْدُ، علَى زَانِيَةٍ؟ لَأَتَصَدَّقَنَّ بصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا في يَدَيْ غَنِيٍّ، فأصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ علَى غَنِيٍّ، فَقالَ: اللَّهُمَّ لكَ الحَمْدُ، علَى سَارِقٍ وعلَى زَانِيَةٍ وعلَى غَنِيٍّ، فَأُتِيَ فقِيلَ له: أَمَّا صَدَقَتُكَ علَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عن سَرِقَتِهِ، وأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عن زِنَاهَا، وأَمَّا الغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فيُنْفِقُ ممَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ.الراوي : أبو هريرة - المصدر : صحيح البخاري. وفي الحديثِ : النِّيةُ الطيِّبةُ يحصُلُ بها الثَّمراتُ الطيِّبةُ. وفي الحديثِ: دليلٌ على أنَّ الإنسانَ إذا نَوى الخيرَ وسَعى فيه وأخطأَ، فإنَّه يُكتَبُ له ولا يضُرُّه. وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ : أي: إنَّ أيَّ صدقة تَتصدَّقون بها، قليلة كانت أو كثيرًة؛ فإنَّ أجرها يُؤدَّى إليكم في الآخرة كاملًا من غير نَقْص؛ فلا يَضيع عنده سبحانه مثقالُ ذرَّةٍ من ذلك. وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ: أي لا تُنْقَصون شيئًا مما وعدكم الله به على نفقتكم في سبيله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "........ يا كعبُ بنَ عُجرةَ الصَّلاةُ برهانٌ والصَّومُ جنَّةٌ حصينةٌ والصَّدَقةُ تطفئُ الخطيئةَ كما يُطفئُ الماءُ النَّارَ ........"الراوي : كعب بن عجرة - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الترمذي-صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مَن تَصَدَّقَ بعَدْلِ تَمْرَةٍ مِن كَسْبٍ طَيِّبٍ، ولَا يَقْبَلُ اللَّهُ إلَّا الطَّيِّبَ، وإنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، كما يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ".الراوي : أبو هريرة - صحيح البخاري. في هذا الحَديثِ يُرغِّبُنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الصَّدَقاتِ وإنْ كانتْ بأقَلِّ القليلِ، فيُخبِرُ أنَّ مَن تَصدَّقَ بقِيمةِ تَمرةٍ مِن كَسْبٍ طيِّبٍ حَلالٍ -ولا يقبَلُ اللهُ إلَّا الكسْبَ الحلالَ- فإنَّ اللهَ سُبحانَه وتعالَى يَتقبَّلُها بيَمينِه كَرامةً لها، وكِلْتَا يَدَيْه تعالَى يَمِينٌ مُبارَكةٌ، ثمَّ يُنَمِّيها ويُضاعِفُ أجرَها لِتَثقُلَ في ميزانِ صاحبِها، كما يُربِّي المرءُ مُهْرَه الصَّغيرَ مِن الخَيْلِ الَّذي يَحتاجُ للرِّعايةِ والتَّربيَةِ، حتَّى تَكونَ تلك الصَّدقةُ مِثلَ الجبَلِ حَجْمًا وثِقَلًا يومَ القِيامةِ. وفي الحديثِ: أنَّ الصَّدقةَ لا تُقبَلُ عندَ اللهِ تعالَى إلَّا إذا كانت طيِّبةً؛ بأن تَكونَ خالصةً لله، ومِن كسْبٍ حلالٍ. وفيه: أنَّ الصَّدقةَ لا تُقوَّمُ بحَجمِها، وإنَّما تُقوَّمُ بإخلاصِ صاحِبِها، وبالمالِ الَّذي خرَجَتْ منه، حلالًا كان أو حرامًا.الدرر السنية. " لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ"273.بعد هذا التحريض الحكيم على بذل الأموال في وجوه الخير، خص- سبحانه - بالذكر طائفة من المؤمنين هي أولى الناس بالعون والمساعدة، ووصف هذه الطائفة بست صفات من شأنها أن تحمل العقلاء على المسارعة في إكرام أفرادها وسد حاجتهم. أحدها الفقر، والفقير هو المعدِمأي الذين هم في حاجة إلى العون والمساعدة لفقرهم واحتياجهم إلى ضرورات الحياة. والثاني قوله: الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ : والإحصار في اللغة هو أن يعرض للرجل ما يحول بينه وبين ما يريده بسبب مرض أو شيخوخة أو عدو أو ذهاب نفقة أو ما يجري مجرى هذه الأشياء. والمعنى: اجعلوا الكثير مما تنفقونه- أيها المؤمنون- لهؤلاء الفقراء الذين حصروا أنفسهم ووقفوها على الطاعات المتنوعة التي من أعظمها الجهاد في سبيل الله، أو الذين مُنِعُوا من الكسب بسبب مرضهم أو شيخوختهم، أو غير ذلك من الأسباب التي جعلتهم في حالة شديدة من الفاقة والاحتياج.وعبر في الجملة الكريمة "بأحصروا" بالبناء للمجهول، للإشعار بأن فقرهم لم يكن بسبب تكاسلهم وإهمالهم في مباشرة الأسباب، وإنما كان لأسباب خارجة عن إرادتهم. وقوله: فِي سَبِيلِ اللَّهِ تكريم وتشريف لهم، أي أن ما نزل بهم من فقر واحتياج كان بسبب إيثارهم إعلاء كلمة الله على أي شيء آخر، ففي سبيل الله هاجروا، وفي سبيل الله تركوا أموالهم فصاروا فقراء، وفي سبيل الله وقفوا أنفسهم على الجهاد، وفي سبيل الله أصابهم ما أصابهم وهم يطلبون أداء ما كلفهم- سبحانه - بأدائه. الثالث قوله: لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ: عجزهم عن الأسفار لطلب الرزق والتكسب ، الرابع قوله: يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ: الحسبان بحسب ظاهر الحال، أي الجاهل بأحوالهم الذي لا يعرفهم يظنهم أغنياء مع أنهم فقراء بحسب ظاهر حالهم، من أي شيء؟ قال" مِنَ التَّعَفُّفِ" أي: بسبب تعففهم وعدم سؤالهم الناس لكمال عفتهم. ، وهذا بيان لصدق صبرهم وحسن تعففهم. الخامس: قوله: تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ - أي: بالعلامة التي ذكرها الله في وصفهم، وهذا لا ينافي قوله: يحسبهم الجاهل أغنياء فإن الجاهل بحالهم ليس له فطنة يتفرس بها ما هم عليه، وأما الفطن المتفرس فمجرد ما يراهم يعرفهم بعلامتهم، فالحسبان بحسب ظاهر الحال، وأما "تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ" فهو بمقتضى الفراسة والنظر والتدقيق، وكثير من الناس يكون عنده من الفراسة ودقة النظر ما يعرف به الأحوال الباطنة، فهؤلاء إذا رأيتهم عرفتهم بسيماهم، السيما بمعنى العلامة. السادس قوله: لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا: الإلحاف هو الإلحاح في المسألة، قوله"لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا" إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ فإن النفي للقيد، يعني: لا يسألون الناس سؤال إلحاف، ولكن يسألونهم سؤال تلطف وحياء وخجل، إذا رده المسؤول مرة ما عاد إليه مرة أخرى، هذا مقتضى ظاهر اللفظ، لكن مقتضى السياق وأن المقام مقام ثناء أن النفي نفي للقيد الذي هو الإلحاف والمقيد الذي هو السؤال، فهم لا يسألون الناس إلحافًا ولا غير إلحاف، بدليل قوله"يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ" ولو كانوا يسألون ما حسبهم الجاهل أغنياء، بل لظنهم فقراء بسبب سؤالهم، لكنه ذكر أعلى أنواع السؤال المذموم وهو الإلحاح ونفاه عنهم ؛ ولهذا تجد الإنسان إذا ألحَّ وإن كان فقيرًا يُثقِل عليك، وتَمل مسألته حتى ربما تأخذك العزة بالإثم ولا تعطيه مع علمك باستحقاقه؛ لأنه ألح، وتجد الإنسان الذي يظهر بمظهر الغني المتعفف تجدك ترق له وتعطيه أكثر مما تعطي السائل فهؤلاء أولى الناس وأحقهم بالصدقات لما وصفهم به من جميل الصفات. قال صلى الله عليه وسلم"ليسَ المِسْكِينُ الذي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ والتَّمْرَتَانِ، ولَا اللُّقْمَةُ ولَا اللُّقْمَتَانِ، إنَّما المِسْكِينُ الذي يَتَعَفَّفُ، واقْرَؤُوا إنْ شِئْتُمْ يَعْنِي قَوْلَهُ"لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إلْحَافًا"الراوي : أبو هريرة - صحيح البخاري. وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ: وهذه عامة أي خير يكون فإن الله به عليم. أي: إنَّ كلَّ ما تُنفِقونه من أيِّ خيرٍ كان قليلًا أو كثيرًا، فإنَّ الله تعالى يعلمه، ويُحصيه لكم، وسيَجزيكم عليه أتمَّ الجزاء. أي: وما تنفقوا من خير سواء أكان المنفَق قليلا أم كثيرا سرا أم علنا فإن الله يعلمه ويُحصيه لكم، وسيجازيكم عليه بأجزل الثواب، وأعظم العطاء. *قال الشيخ العثيمين في تفسيره : من فوائد الآية الكريمة: أن تشاغل الإنسان بعمل يعد من سبيل الله يبيح أن نعطيه وننفق عليه، فلو تشاغل القادر على الكسب بطلب العلم فإننا نعطيه حتى من الصدقة الواجبة ليتفرغ لطلب العلم، ولو تفرغ إنسان للجهاد في سبيل الله أعطيناه ولَّا لا؟ نعم، أعطيناه، ولو من الصدقة الواجبة. طيب، لو تفرغ الإنسان للعبادة فإنه لا يُعطى إلا من الصدقة المستحبة، أما من الزكاة فلا يُعطى، لأنه تفرغ لنفع قاصر لا يتعداه، وفرق بين النفع القاصر والنفع العام. "الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ"274. بعد أن رغب سبحانه في الآ يات السالفة في الإنفاق وبين فوائده للمنفقين والمنفق عليهم ......، بيَّنَ هنا فضيلة الإنفاق في جميع الأوقات والأحوال ومضاعفة الأجر على ذلك. أي: إنَّ الإنفاق في أيِّ وقتٍ كان ليلًا أو نهارًا، وعلى أيِّ حالٍ وُجِد سرًّا أو علانيةً، فإنَّه سبب الجزاء على كلِّ حال؛ فليبادرْ إليه العبد- ولا يؤخِّره- في جميع الأوقات والأحوال وفي تقديم السر على العلانية والليل على النهار دليل على أن الصدقة كلما كانت أخفى فهي أفضل وأولى، ولكن قد تكون علانية أفضل إذا ترتب على ذلك مصلحة. ، فإنَّ مَن يقوم بذلك، له يوم القيامة أجرٌ عظيمٌ، فثوابهم عند الله مدخرًا يجدونه أحوج ما يكونون إليه، ولا يُصيبه خوفٌ على ما يُستقبَل، ولا يَعْتريه حزنٌ على ما مضَى، فيفوز بحصول المرغوب، والنَّجاة من المرهوب. "الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" 275. لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات ، المخرِجين الزكوات ، المتفضلين بالبر والصلات لذوي الحاجات والقرابات في جميع الأحوال والآنات شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات ، فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم. الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا أي يتعاملون به أخذا وإعطاء لا يَقُومُونَإِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ : لا يقومونيوم القيامة للقاء الله إلا قيامًا كقيام المتخبِط المصروع المجنون حال صرعه وجنونه، وتخبط الشيطان له، وذلك لأنه يقوم قيامًا منكرًا مفزعا بسبب أخذه الربا الذي حرم الله أخذه. فالآية الكريمة تصور المرابي بتلك الصورة المرعبة المفزعة، التي تحمل كل عاقل على الابتعاد عن كل مُعامَلة يشم منها رائحة الربا. وقد رجح الإمام الرازي أن الآية الكريمة تصور حال المرابي في الدنيا والآخرة فقال ما ملخصه"إن الشيطان يدعو إلى طلب اللذات والشهوات والاشتغال بغير الله، ومن كان كذلك كان في أمر الدنيا متخبطا ...وآكل الربا بلا شك أنه يكون مُفْرِطًا في حب الدنيا متهالكا فيها، فإذا مات على ذلك الحب صار ذلك حجابًا بينه وبين الله-تبارك وتعالى-، فالتخبط الذي كان حاصلا له في الدنيا بسبب حب المال أورثه التخبط في الآخرة وأوقعه في ذل الحجاب عن الله ، ...." .ا.هـ. الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة للشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله: ربا الفضل يعني ربا الزيادة، مثل أن يبيع الإنسان درهمًا بدرهمين، أو دينارًا بدينارين أو صاعًا من التمر بصاعين من التمر هذا ربا الفضل، ربا النسيئة تأخير القبض فيما يجب فيه القبض، فمثلاً الواجب فيما إذا باع الإنسان تمرًا بتمر، أن يكون التمران متساويين، وأن يكون القبض قبل التفرق، وإذا باع تمرًا بشعير، فالواجب أن يكون التقابض قبل التفرق، فإن تأخر القبض صار الأول؛ أي بيع تمر بتمر مثله فيه ربا النسيئة، وكذلك إذا باع تمرًا بشعير وتأخر القبض؛ فيكون فيه ربا نسيئة، وقد يجتمع ربا النسيئة والفضل؛ إذا باع تمرًا بأكثر منه، مع تأخر القبض؛ فهذا فيه ربا الفضل؛ من أجل الزيادة، وفيه ربا النسيئة؛ من أجل تأخير القبض؛ فصار ربا النسيئة يعني تأخير القبض فيما يجب فيه التقابض قبل التفرق من الربويات، والفضل هو الزيادة فيما يشترط فيه التساوي. قال عبادة بن الصامت :غَزَوْنَا غَزَاةً وعلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ، فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً، فَكانَ فِيما غَنِمْنَا آنِيَةٌ مِن فِضَّةٍ، فأمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَهَا في أَعْطِيَاتِ النَّاسِ، فَتَسَارَعَ النَّاسُ في ذلكَ، فَبَلَغَ عُبَادَةَ بنَ الصَّامِتِ، فَقَامَ، فَقالَ: إنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يَنْهَى عن بَيْعِ الذَّهَبِ بالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بالفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بالبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بالمِلْحِ، إلَّا سَوَاءً بسَوَاءٍ، عَيْنًا بعَيْنٍ، فمَن زَادَ، أَوِ ازْدَادَ، فقَدْ أَرْبَى، فَرَدَّ النَّاسُ ما أَخَذُوا، فَبَلَغَ ذلكَ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ خَطِيبًا، فَقالَ: أَلَا ما بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عن رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ قدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصْحَبُهُ، فَلَمْ نَسْمَعْهَا منه؟! فَقَامَ عُبَادَةُ بنُ الصَّامِتِ فأعَادَ القِصَّةَ، ثُمَّ قالَ: لَنُحَدِّثَنَّ بما سَمِعْنَا مِن رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، وإنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ، أَوْ قالَ: وإنْ رَغِمَ، ما أُبَالِي أَنْ لا أَصْحَبَهُ في جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ."الراوي : عبادة بن الصامت- صحيح مسلم. وفي الحديثِ: الاهتمامُ بتَبليغِ السُّننِ ونشْرِ العلمِ، وإنْ كَرِهه مَن كَرِهه.. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا : بيان لزعمهم الباطل الذي سوغ لهم التعامل بالربا، ورد عليه بما يهدمه. واسم الإشارة " ذَلِكَ " يعود إلى الأكل أو إلى العقاب الذي نزل بهم. والمعنى: ذلك الأكل الذي استحلوه عن طريق الربا، أو ذلك العذاب الذي حل بهم والذي من مظاهره قيامهم المتخبط، سببه قولهم إن البيع الذي أحله الله يشابه الربا الذي نتعامل به في أن كلا منهما معاوضة. قد بلغ من اعتقادهم في حِل الربا أنهم جعلوه أصلا وقانونا في الحل حتى شبهوا به البيع. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا: جملة مستأنفة، وهي رد من الله-تبارك وتعالى- عليهم، وإنكار لتسويتهم الربا بالبيع. قال الآلوسى: وحاصل هذا الرد من الله-تبارك وتعالى- عليهم: أن ما ذكرتم- من أن الربا مثل البيع- قياس فاسد الوضع لأنه معارض للنص فهو من عمل الشيطان، على أن بين البابين فرقا، وهو أن من باع ثوبا يساوى درهما بدرهمين فقد جعل الثوب مقابلا لدرهمين فلا شيء منهما إلا وهو في مقابلة شيء من الثواب. وأما إذا باع درهما بدرهمين فقد أخذ الدرهم الزائد بدون عوض، ولا يمكن جعل الإمهال عوضا إذ الإمهال ليس بمال في مقابلة المال. وقوله: فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. تفريع على الوعيد السابق في قوله: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا.. إلخ . والمجيء بمعنى العلم والبلاغ، والموعظة: ما يعظ الله-تبارك وتعالى- به عباده عن طريق زجرهم وتخويفهم وتذكيرهم بسوء عاقبة المخالفين لأوامره.أي: فمن بلغه نهي الله-تبارك وتعالى- عن الربا، فامتثل وأطاع وابتعد عما نهاه الله عنه، فَلَهُ ما سَلَفَ أي فله ما تقدم قبضه من مال الربا قبل التحريم وليس له ما تقدم الاتفاق عليه ولم يقبضه.. لأن الله-تبارك وتعالى- يقول بعد ذلك وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ ... وقوله: وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ أي أمر هذا المرابي الذي تعامل بالربا قبل التحريم واجتنبه بعده، أمْره مفوض إلى الله-تبارك وتعالى-فهو الذي يعامله بما يقتضيه فضله وعفوه وكرمه. قال ابن كثير: قوله فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ.. إلخ أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة لقوله: عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وكما قال النبيصلّى الله عليه وسلّم يوم فتح مكة"ألا وإنَّ كلَّ شيءٍ مِن أمرِ الجاهليَّةِ مَوضوعٌ تحتَ قدميَّ هاتَينِ .........وربا الجاهليَّةِ موضوعٌ وأوَّلُ ربًا أضعُهُ رِبانا رِبا العبَّاسِ بنِ عبدِ المُطَّلبِ فإنَّهُ مَوضوعٌ كلُّهُ......" الراوي : جابر بن عبدالله - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم : 2512 - خلاصة حكم المحدث : صحيح . ، ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية بل عفا عما سلف كما قال-تبارك وتعالى"فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ" أي فله ما كان قد أكل من الربا قبل التحريم.وفي هذه الجملة الكريمة بيان لمظهر من مظاهر السماحة فيما شرعه الله لعباده، لأنه- سبحانه - لم يعاقب المرابين على ما مضى من أمرهم قبل وجود الأمر والنهي، ولم يجعل تشريعه بأثر رجعي بل جعله للمستقبل، إذ الإسلام يجُب ما قبله.فما أكله المرابى قبل تحريم الربا فلا عقاب عليه فيه وهو ملك له، إلا أنه ليس له أن يتعامل به بعد التحريم، وإذا تعامل به فلن تقبل توبته حتى يتخلص من هذا المال الناتج عنه الربا. ولقد توعد الله-تبارك وتعالى-من يعود إلى التعامل بالربا بعد أن حرمه الله-تبارك وتعالى- فقال" وَمَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ". أي ومن عاد إلى التعامل بالربا بعد أن نهى الله عنه فأولئك العائدون هم أصحاب النار الملازمون لها، والماكثون فيها بسبب تعديهم لما نهى الله عنه. وفي هذه الجملة الكريمة تأكيد للعقاب النازل بأولئك العائدين بوجوه من المؤكدات منها:التعبير فيها بأولئك التي تدل على البعيد فهم بعيدون عن رحمة الله، والتعبير بالجملة الاسمية التي تفيد الدوام والاستمرار والتعبير، بكلمة أصحاب الدالة على الملازمة والمصاحبة، وبكلمة خالِدُونَ التي تدل على طول المكث. " يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ"276. أي: أن المال الذي يدخله الربا يذهبه الله، ويذهب بركته. أما المال الحلال الطيب الذي يبذل منه صاحبه في سبيل الله فإنه- سبحانه - يباركه وينميه ويزيده لصاحبه. واعلم أن محق الربا وإرباء الصدقات يكون في الدنيا و الآخرة لعموم الأدلة. روى البخاري عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم " مَن تَصَدَّقَ بعَدْلِ تَمْرَةٍ مِن كَسْبٍ طَيِّبٍ، ولَا يَقْبَلُ اللَّهُ إلَّا الطَّيِّبَ، وإنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، كما يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ."الراوي : أبو هريرة/ صحيح البخاري / الصفحة أو الرقم: 1410. في هذا الحَديثِ يُرغِّبُنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الصَّدَقاتِ وإنْ كانتْ بأقَلِّ القليلِ، فيُخبِرُ أنَّ مَن تَصدَّقَ بقِيمةِ تَمرةٍ مِن كَسْبٍ طيِّبٍحَلالٍ -ولا يقبَلُ اللهُ إلَّا الكسْبَ الحلالَ- فإنَّ اللهَ سُبحانَه وتعالَى يَتقبَّلُها بيَمينِه كَرامةً لها، وكِلْتَا يَدَيْه تعالَى يَمِينٌ مُبارَكةٌ، ثمَّ يُنَمِّيها ويُضاعِفُ أجرَها لِتَثقُلَ في ميزانِ صاحبِها، كما يُربِّي المرءُ مُهْرَه الصَّغيرَ مِن الخَيْلِ الَّذي يَحتاجُ للرِّعايةِ والتَّربيَةِ، حتَّى تَكونَ تلك الصَّدقةُ مِثلَ الجبَلِ حَجْمًا وثِقَلًا يومَ القِيامةِ. وفي الحديثِ: أنَّ الصَّدقةَ لا تُقبَلُ عندَ اللهِ تعالَى إلَّا إذا كانت طيِّبةً؛ بأن تَكونَ خالصةً لله، ومِن كسْبٍ حلالٍ. وفيه: أنَّ الصَّدقةَ لا تُقوَّمُ بحَجمِها، وإنَّما تُقوَّمُ بإخلاصِ صاحِبِها، وبالمالِ الَّذي خرَجَتْ منه، حلالًا كان أو حرامًا.الدرر السنية. ما أحدٌ أكثرَ من الربا إلَّا كان عاقبةُ أمرِه إلى قِلَّةٍ " الراوي : عبدالله بن مسعود / المحدث :الألباني /صحيح ابن ماجه /الصفحة أو الرقم: 2/241 / صحيح. ففي هذه الآية الكريمة بشارة عظيمة للمتصدقين، وتهديد شديد للمرابين ثم ختم- سبحانه - الآية بقوله: وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ: أي: أن الله-تبارك وتعالى- لا يرضى عن كل من كان شأنه الستر لنعمه والجحود لها، والتمادي في ارتكاب المنكرات، والابتعاد عن فعل الخيرات. أي: إنَّ الله تعالى لا يحبُّ كلَّ من كان كثيرَ الكُفْران، مُصرًّا على الكُفْر بنِعَمه، مقيمًا على ذلك، مُستحِلًّا أكْلَ الرِّبا، متماديًا في الإثم فيما نهاه عنه من أكْله وتَعاطِيه، وغير ذلك من معاصيه،فالآية الكريمة تهديد شديد لمن استحلوا الربا، أو فعلوه مع عدم استحلالهم له. "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ"277. وبعد هذا التهديد الشديد للمتعاملين بالربا، ساق- سبحانه - آية فيها أحسن البشارات للمؤمنين الصادقين . إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا أى إيمانا كاملا بكل ما أمر الله به وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أى الأعمال الصالحة التي تصلح بها نفوسهم والتي من جملتها الإحسان إلى المحتاجين، والابتعاد عن الربا والمرابين وَأَقامُوا الصَّلاةَ بالطريقة التي أمر الله بها، بأن يؤدوها في أوقاتها بخشوع واطمئنان وَآتَوُا الزَّكاةَ أي أعطوها لمستحقيها بإخلاص وطيب نفس. هؤلاء الذين اتصفوا بكل هذه الصفات الفاضلة لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ أي لهم ثوابهم الكامل عند خالقهم ورازقهم ومربيهم. وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ يوم الفزع الأكبر ، وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ لأي سبب من الأسباب، لأن ما هم فيه من أمان واطمئنان ورضوان من الله-تبارك وتعالى- يجعلهم في فرح دائم، وفي سرور مقيم. "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ" 278. لَمَّا بيَّن في الآية المتقدِّمة أنَّ مَن انتهى عن الرِّبا فله ما سَلَف، فقد كان يجوز أن يُظَنَّ أنه لا فرْق بين المقبوضِ منه والباقي في ذِمَّة القوم، وأنَّ الممنوع هو إنشاء عَقدٍ رِبويٍّ بعد التحريم؛ لذا أَزالَ تعالى هذا الاحتمالَ بأنْ أمَر بترك ما بقي من الرِّبا في العقود السابقة، قبل التَّحريم. أي: تحريم ما بقي دينًا من الرِّبا وإيجاب أخذ رأس المال دون الزِّيادة على جهة الرِّبا. إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ حض لهم على ترك الربا أي إن كنتم مؤمنين حق الإيمان فامتثلوا أمر الله وذروا ما بقي من الربا مما زاد على رءوس أموالكم. "فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ "279. أي: فإن لم تتركوا ما بقي لكم على النَّاس من زيادةٍ على رأس المال، مُستَمرِّين على تَعاطي الرِّبا بعد إنذاركم ونهيكم عن ذلك، فأَعلِموا أنفسَكم وغيرَكم، مُستيقنين أنَّ الله تعالى يتوعَّدكم بحرب كائنة من الله-تبارك وتعالى- ورسوله، ومن حاربه الله ورسوله لا يفلح أبدًا. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ :أي: إن تُبْتُم فتركتُم أكْلَ الرِّبا، وأَنَبْتُم إلى الله عزَّ وجلَّ، فلكم رؤوس أموالكم من الدُّيون التي لكم على النَّاس دون الزِّيادة التي أحدثتموها على ذلك، فلا تَظْلِمُونَ الناسَ بأخْذ الزِّيادة، وَلا تُظْلَمُون بإعطائكم رؤوسَ أموالكم ناقصةً . " وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ" 280. أي: إنْ كان الذي عليه الدَّين مُعسِرًا لا يَجِد ما يَردُّ به حقَّكم- وهو رؤوس أموالكم التي أَسلفتُموه إيَّاها دون زيادة- فعليكم أن تُمهِلوه حتى يتيسَّر له الوفاءُ به. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ :أي: إنَّ تصدُّقَكم على المدينِ المعسرِ بالتنازلِ والعفو عمَّا لكم عليه أو بإسقاط بعضه، خيرٌ لكم من إمهاله حتى يتيسَّر له القيام بردِّه لكم، فقوموا بذلك إذًا إن كنتم من ذوي العِلْم بفضل الصَّدقة، وما لصاحبها من ثوابٍ عظيم. "من أنظرَ معسرًا كانَ لَه بِكلِّ يومٍ صدقةٌ ومن أنظرَه بعدَ حلِّهِ كانَ لَه مثلُه في كلِّ يومٍ صدقةٌ"الراوي: بريدة بن الحصيب الأسلمي/ المحدث: الألباني / صحيح ابن ماجه/ الصفحة أو الرقم/ 1977-خلاصة حكم المحدث:صحيح "من نفَّس عن غريِمه ، أو محا عنه ، كان في ظلِّ العرشِ يومَ القيامةِ"الراوي: أبو قتادة /المحدث :الألباني / صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6576-خلاصة حكم المحدث:صحيح. " أُتِيَ اللَّهُ بعَبْدٍ مِن عِبَادِهِ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَقالَ له: مَاذَا عَمِلْتَ في الدُّنْيَا؟ قالَ: وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، قالَ: يا رَبِّ آتَيْتَنِي مَالَكَ، فَكُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ، وَكانَ مِن خُلُقِي الجَوَازُ، فَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ علَى المُوسِرِ، وَأُنْظِرُ المُعْسِرَ، فَقالَ اللَّهُ: أَنَا أَحَقُّ بذَا مِنْكَ، تَجَاوَزُوا عن عَبْدِي. فَقالَ عُقْبَةُ بنُ عَامِرٍ الجُهَنِيُّ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الأنْصَارِيُّ، هَكَذَا سَمِعْنَاهُ مِن في رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ."الراوي : حذيفة بن اليمان -وعقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري - صحيح مسلم. " وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ" 281. أي: احذروا- أيُّها الناس- يومًا تزول فيه هذه الدنيا وما فيها من الأموال وغيرها، فترجعون إلى الله فتَلقَونه فيه، فاحذروا أن تَرِدوا عليه بسيِّئات تُهلِككم، وبلا حسنات تُنجِيكم، فتَستحِقُّوا عقابَ الله تعالى، وهو يوم مُجازاة الأعمال، فتستوفي فيه كلُّ نَفْس جزاءها بالعدل من ربِّها، على ما قدَّمت واكتسَبتْ من سيِّئ وصالح، لا يُنقَصُون شيئًا من ثواب الحسنات، ولا يُزاد عليهم شيءٌ من عقوبة السيِّئات . فإنَّ ممَّا يُهوِّن على العبدِ التزامَ الأمور الشرعيَّة، واجتنابَ المعاملات الرِّبوية، والإحسانَ إلى المُعسِرين، عِلْمُه بأنَّ له يومًا يَرجِع فيه إلى الله تعالى، ويُوفِّيه عملَه، ولا يظلمه مِثقالَ ذرَّة؛ ففي الآية ترغيبٌ في فِعْل ما أُمِر به أو نُدِب إليه ممَّا سبق؛ لأنَّ في تَرْك المنهيَّات سلامةً من آثامها، وفي فِعْل المطلوبات استكثارًا من ثوابها، والكلُّ يرجع إلى اتِّقاء ذلك اليوم الذي تُطلَب فيه السلامة وكثرة أسباب النجاح، وهو أيضًا صالح للتَّرهيب من ارتكاب ما نهي عنه ممَّا سبَق النَّهي عنه. |
|
|

|
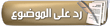 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
 (View-All)
Members who have read this thread in the last 30 days : 0
(View-All)
Members who have read this thread in the last 30 days : 0
|
|
| There are no names to display. |
|
|
 المواضيع المتشابهه
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| فضائل سور القرآن الكريم كما حققها العلامة الألباني.. | أم المجاهدين | روضة القرآن وعلومه | 17 | 19-06-08 07:43 PM |